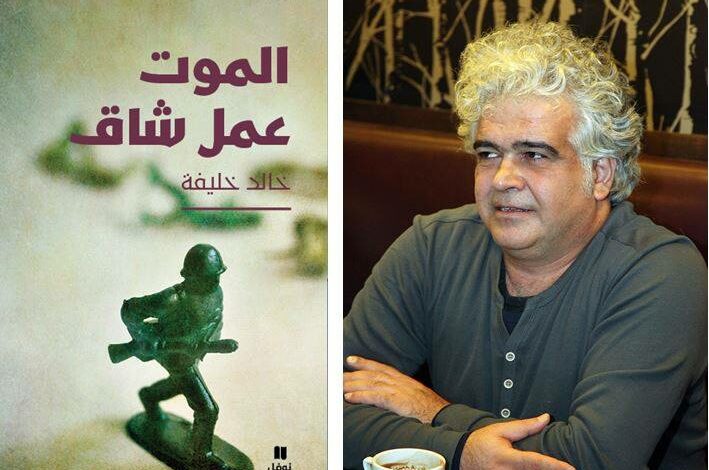لم يخرج فضاء رواية خالد خليفة (الموت عمل شاق) عن رحلة جثمان مدرّس جغرافيا من الجنوب؛ ليدفن في قريته بالشمال السوري، التي استغرقت زمن السرد، نحو ثلاثة أيام، ولم يفت السارد استرجاع أحداث رحلة صاحب الجثمان من الشمال إلى الجنوب، بحثًا عن حياة حرّة كريمة افتقدها في موطنه منذ انتحار أخته قبل نحو نصف قرن سابق عن زمن السرد في السنة الثالثة من عمر الثورة السوريّة؛ إذ وجد هذا المدرّس حريته وكرامته لأول مرّة في صفوف شباب الثورة في مدينة س الرامزة لمعظم مدن وبلدات محافظة ريف دمشق، لاسيّما أنّه التقى محبوبته في ميادين الثورة، التي كان قد حلم بها منذ مطلع شبابه.
رحلة الموت برفقة أبنائه، التي بدأت بعد أربع سنوات من انطلاقة الثورة، منذ صار جثمانًا هامدًا، ليودعوه قبرًا يتيمًا، ويعودوا من جديد مستأنفين رحلة الشقاء والذل.. رحلةٌ غطت أرض سوريا، مكافئة العمر الزمني لنظام الموت والقهر والتخلّف والفساد والطائفية، الذي بدأ في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولا يزال جاثمًا على قلوب السوريين؛ زاكمًا أنوف من تبقى حيًّا منهم برائحة موته، أراد خالد خليفة أن يحدد معاني ثورة السوريين الحيّة بإظهار أضدادها، فمنح الجثة بعدًا دلاليًّا للكشف عن أسباب الموت المرتبط بجيش السلطة.
جُلّ أحداث الرواية وقعت في ميكروباص مع ثلاثة أشخاص، كانوا يطلّون على عالم الأحياء من حول جثة أبيهم الممدة على المقعد الخلفيّ؛ حيث تعثّر درب رحلتهم لدفنها.. لم يشغلهم عن فضاء محيطهم سوى سؤال واحد، تعلّق بموعد دفن جثّة أبيهم، آملين أن يجدوا له قبرًا في قريته.
تُرى.. ما الذي أراد خالد خليفة قوله باختياره بطل نصّه جثّة؟ هل أراد برحلة الأخوة الثلاثة معادلًا لرحلة الثورة المتعثّرة؟ وإلام ترمز الجثّة التي لم يبق منها سوى ديدانها المتحركة، أتكون معادلًا لسلطة نظام الحكم، التي أفرزت هذا الكمّ الكبير من شبيحتها وطائفييها وتكفيرييها المجرمين؟ هل ديدان الجثة التي انسلت من الجثة نحو أشياء الميكرو باص دالة على حركة ميليشيات السلطة الطائفية والتكفيرية في الجانب الآخر؟ أأراد أن يدلّ القارئ على درب دفن الجثة التي لم يتحرك فيها وحولها سوى تلك الديدان؟ مهما تكن الإجابة، فقد جعل خليفة من الموت ترسيمة كررها في المتن الحكائي، وربط فيها نصّه الروائي في كامل مساحته السردية.
في فصل: لو أنّك أكياس كمون يعرّف الكاتب بعبد اللطيف السالم، مدرس جغرافيا، الذي هجر قريته في شمال حلب منذ شبابه، واستقرّ في بلدة س في ريف دمشق، بنى فيها بيتًا، وكان محبوبًا اجتماعيًّا ومدرّسًا ناجحًا، له صبيّ اسمه حسين طرده من بيته لتمرده، وآخر نبيل كان يميل للإذعان، تخرّج من الجامعة، وعاش مع أبيه، وابنته فاطمة تزوجت وخلّفت ذرية، توفيت زوجته، فتزوج من نيفين، التي كان يحلم بها منذ التحقت بتعليم مادة الفنون، حين كان مدرّسًا شابًّا.. توفيت زوجته، وتوفي زوجُها، فحصل اقترانه بها، عند انطلاق الثورة السورية والتحاقه بميادين الثوار معها، بعد أن قُتل ابنها الطبيب تحت التعذيب في فرع المخابرات، واستُشهد أخيه الأصغر، الذي التحق بالجيش الحرّ في درعا انتقامًا لأخيه.
بعد أربع سنوات من عمر الثورة تسلّل من بلدة س المحرّرة، وحلّ ضيفًا على ابنه نبيل المطلّق من زوجته، المدلّع باسم: بلبل، فلاحظ الابن إعياء شديدًا حلّ على أبيه، وبعد فترة وجيزة نقله إلى المستشفى، وحينما حضرت منيته، أوصاه أن يدفنه في قبر أخته ليلى، التي حرقت نفسها اعتراضًا على زوج فرضه أبوها عليها في قريتهم العنابية شمال سوريا، وسرعان ما توفي أبو بلبل، لتبدأ رحلة دفن الجثّة مع أخويه، منذ تمّ رميّ الجثّة من برّاد موتى المستشفى؛ ليستوعب قتلى النظام، حتّى وصولهم إلى قريتهم بعد ثلاثة أيام متتاليّة.
اختار المؤلّف ساردًا ذا سلطة، يكشف عن معاناة شخوصه، ويخبر عمّا تخفيه بواطنهم من هموم وهواجس، فوضّح أفكار الأخوة الثلاثة المحيطين بالجثة وانفعالاتهم وسلوكهم، وكشف عن وحدة اتجاهاتهم نحو دفن الجثّة، التي عكست قدرة كل واحد منهم على تحمل تفسخها ورائحتها النتنة.. انتظر بلبل حتّى تمكّن من تسلّم جثة أبيه نظاميًّا، وغادر هاربًا من الجحيم، ليدخل في رحلة الموت مع أخويه حسين وفاطمة، وشكّل الكاتب للحكاية بنية مكانية مغلقة؛ إذ انتظم محورها الرئيس بموجب المكان، وهو ميكروباص أودع الجثمان داخلع، وجعله ناظمًا للحركة المشلولة للأخوة الثلاثة المرافقين للجثة، مكثًّفًا زمن السرد حاضرًا، مدعّمًا موقفه من المأساة بتداعيات أبرز من خلالها ملامح ماضٍ غير إنسانيّ.
طوال مسار السرد، يعيش القارئ حالة ذهول؛ متأمّلًا تفاصيل رحلة الموت، التي انتظمت أحداثها وفق نظام نسقيّ، أحداث وقع جلّها (في زمن السرد)، التي يعيشها السوريون بعد أربع سنوات من تعرّضهم للقتل والاعتقال والتهجير، لقد استطاع الكاتب أن يبني فضاء شاملًا لأجواء الجريمة في حيّز مكانيّ منغلق، اكتنفه استعارة كبرى؛ إذ اختار الكاتب جسد جثّة مدرس الجغرافيا، الأب، بصفته علاعة استعارية منحها من صفات فريقي الحرب الأهلية، طائفيين وتكفيريين، حاملي رايات الموت تحت سماء سوريا، الوطن، وفوق ترابها الغالي على أهلها، مومئًا لسماتهم اللاإنسانية.
قسم السارد مسار السرد بين ممارسات السلطة وشبيحتها وجيشها وميليشيات شيعية منذ لفظ الأب أنفاسه الأخيرة، وحتّى وصول الجثة إلى آخر حاجز للسلطة، فغطّى أكثر من ثلاثة أرباع مساحة السرد، وأقل من الربع الأخير، كان على حواجز الميليشيات التكفيرية، الذين جلّ أفرادهم غرباء، وليسوا سوريين.
قبيل خروج ميكرو باص حسين من دمشق، تجاوزهم موكب سيارتي إسعاف محملتين بجنود النظام المصابين، فأعاقتا السير، وتسبّبتا ببصقة أحد العساكر على حسين.. تذكّر بلبل كيف لم يعد للشهيد ذكر على شاشات التلفزة، ولم يعد النظام يشيّع قتلاه، وبهتت تصريحات أهالي الشهداء، بأنّ أبناءهم يقدّمون أرواحهم فداء للوطن والقائد، وشعر بالتميّز لإحاطة جثة أبيه بأبنائه الثلاثة، وبموته أيام البرد الذي يمنع تفسّخها، على الرغم من إدراكه أنّها جنازة تمثّل: [حدثًا عاديًّا لا يثير أيّ شيء سوى حسد الأحياء، الذين تحوّلت حياتهم إلى انتظار مؤلم للموت] ص15، عالم جثّة مدرس الجغرافيا وإطارها مقعد في ميكروباص مقيمةٌ فيه، تنتظر من يدفنها وَفق وصيّة ثقيلة على الأبناء، لوحة قاتمة ترافق مشاهد خلفية تمتدّ من أقصى شمال سوريا إلى جنوب عاصمتها، يتناوب فيها الظلم والقهر والجريمة عند كل حاجز من حواجز عسكرية طائفية أو تكفيرية.. لم يوارب خليفة فيما أراد قوله، كان واضحًا كوضوح الموت المرافق للسوريين والمتغلغل داخل عقولهم والمبثوث في حياتهم، كما كان واعيًا للمعنى الذي تعلّق بملكة الإحساس التي بثّت أصداء للمعاني وفق علاقات جدلت بين الموت المستوطن وحياة أقرب إلى العدم، ووجّه سرديته خيطيًّا.
منذ مطلع طريق دمشق حلب الدوليّ، أجبر حسين على انحرافه بسيارته الميكرو باص نحو زواريب ضيقة وسط بساتين الزيتون المحترقة، سمعوا: [أصوات قصف الطيران قريبة منهم، تطلق صواريخها من ارتفاع منخفض…] ص24، وشعر بلبل بالمهانة لمعاملة جثّة أبيه باستهتار الحواجز الأمنية، ثمّ تذكّر آلاف الجثث المتروكة في العراء للطيور الجارحة والكلاب.
انفتح الكاتب ساردًا شذرات من ماضي سوريا المأساوي المؤسّس لهذه الثورة، موظّفًا الخطف خلفًا Flashback ومسترجعًا بذاكرة شخوص روايته آلامًا تعايشوا معها، فحسين طُرد من بيت أبيه وهو طالب ثانوي، واقترب من بؤر الفساد، التي كانت تعمّ سوريا منذ مطلع السبعينيات، وفاطمة طلّقت زوجها الأول، الذي عمل قوادًا لضباط الأمن والشبيحة، وكان أملها ينمو مع ابنها في كلية طب الأسنان، وابنتها المتفوقة في مدرستها من زوجها الثاني، بحيث لا يلبث السارد لحظة، حتى يعود لواقع يطغى على كلّ الوجود، واقع الموت، مما أضفى على عناصر السرد وتيمات قصته تجانسَا واتساقًا منذ فارق الأب الحياة في مستشفى لم تعد تتسع للموتى، إلى خروجهم من دمشق، حيث انتظروا في طابور على حاجز مخابرات، وحين قدم حسين أوراقه عرف بوجود أمر باعتقال الجثة، لأنّ صاحبها مطلوب لفرع المخابرات، وبعد أن أودع الأخوة الثلاثة الزنزانة المكتظّة بالمعتقلين، وصفت عجوز لفاطمة خراب أحياء حمص وتهدّمها، وأخبرتها عن اعتقالها ثلاث مرات في أثناء الثورة، فتجرأت فاطمة، وحكت عن قصة ابنة حميها، التي اغتصبوها أربعة أيام متتالية، ورموها جثةّ لأهلها، بعد أن اشتركت بمظاهرة سلميّة فقالت العجوز: [يغتصبون النساء والرجال أيضًا، لن ينسى أحدٌ كلّ هذا الظلم، ولو بعد ألف سنة] ص39. وتمكّن بلبل من رشوة الضابط بمبلغ كبير، فسمح لهم بالمرور، وعرف أنّ: [الموت أصبح عملًا شاقًّا كما هي الحياة بكافة تفاصيلها بالنسبة إلى بلبل] ص47 في بلد: [أصبحت الهوية الشخصية كارثة حقيقية] ص50، حينما يكون صاحبها ابن المناطق الثائرة ضد نظام الموت، إلى أن ساد تغييب الناس والخطف والفديّة والاعتقالات العشوائيّة والردّ بالمثل، الذي وصل إلى ذروته، قبل سنوات مضت عن رحلة جثّة أب مع أبنائه الثلاثة؛ انطلاقًا من بلدة س في الجنوب ومرورًا بدمشق ووسط سوريا، وصولًا إلى أقصى شمالها.
في درب رحلة الموت تذكّر بلبل، سنوات إقامته في حيّ مختلط، الأقليات فيه غالبه، تذكّر كيف ظلّ مطاطئًا، وكيف كان يهرب من نظرات الحقد والكراهية، التي تشيّعه في أثناء مروره، تذكّر كيف وصل أبوه وقطن معه، وكيف تواطأ مع الطبيب الذي عالجه؛ إذ اعتاد تقديم العون للجرحى والمعوزين، كانا يحلمان بنصر الثورة، لقد قام الكاتب بـ: “تشخيص الحياة عن طريق تقديم المونولوجات الداخلية المباشرة للشخصية” ولكن بلبل لم يعنِ له الأمر شيئًا، كان يفكّر فقط في خلاصه من ورطة مرض أبيه، وقبيل الوصول إلى مقبرة العنابيّة، فكّر بلبل بالثوار، بالذين يتغلغلون في كلّ الأمكنة، الممتلكين شيفرات سريّة لا يعرفها هو وأخويه، باتوا لا يعرفون شيئًا سوى حقيقة واحدة هي جثّة، أبيهم التي كادت أن تنفجر فيهم!
كانت الأسئلة المقلقة تتكرر في رؤوس الأخوة، كلما تخلّصوا من حاجز، أصبحوا يسيرون بسيارتهم، ولكنّهم ساكنون مع سكون الجثة ومحيطها داخل السيارة، ولعلّ خالد خليفة سعى إلى تحديد سمات الأشياء ومعانيها بأضدادها، فقيمة الحياة يدركها القارئ من مجاورته الموت، وفضاء الحرية يدركها بانغلاق المكان على جثة تتفسخ، وقد نجح في إبطاء حركة السرد، حين كانوا يتوقفون في الحواجزعن طريق التذكّر الانفرادي لقصص كلّ منهم، أو في التأمّل بالجثّة ومستقبلها، أمّا عندما كانوا يغادرون الميكرو باص، تاركين الجثّة هامدة على كرسيه الأخير، فكان السارد يسرّع من إيقاع سرده السريع Fast speed، ومن ذلك أنّه عندما شعروا بالإرهاق طلب بلبل من أخيه، أن يتوجّه لبلدة ص القريبة، كان يعرف فيها لميا في أثناء دراسته، قبل 25 سنة، كان يعرفها أختًا، وصديقة لأبيه لتوافقهما بمعارضة النظام، تذكّر كيف استجابت لأمر أمّه بترك غرفتها في دير الراهبات، والسكن معهم في غرفة فاطمة، ويبدو أنّ لميا تزوجت (زهير)، الذي كان يحبّها وتحبّه، بعد أن قضى سنوات في معتقلات السلطة، ولم يعن لها نبيل، الذي هي من أسمته بلبل سوى أخ لها، على الرغم من إضماره حبًّا دفينًا.
إنّ رغبتهم في الوصول إلى بلدة ص لم تكن خارج مهمتهم المتعلقة بالحفاظ على الجثة ودفنها في قريتهم الشمالية، ولعلّ أحداث الرواية اقتصرت على ما تستلزمه من مقومات الحفاظ على جثّة لدفنها، وتسريع السرد ارتبط بمهمتهم، أما إبطاء السرد فكان عن طريق الهروب نحو الماضي، لثلاثة أخوة، يضمر الذكران منهما السوء تجاه بعضهما، وأختهما تحاول إبعاد الشرّ عنهما.
وصلوا إلى بيت لميا وزوجها، فاستقبلوا برحابة صدر، وباتوا عندهما، شهدوا وجود عشرات الأشخاص، منهم 30 طفلًا، من الذين شُرّدوا من قراهم يعيشون في منزلهما، أحيت لميا في نفس بلبل قوة الحياة، وكفكفت دموعه، ووصفت أباه بالرجل العظيم والشهيد والثائر، بدّلت كفنه، وثبتت ألواح الثلج على الجثة، التي بدأت تنتفخ وتزرّق من العفن، وعطرته وتركت لفاطمة زجاجة كولونيا، إلى أن تدبّروا أمر خروجهم، واستأنفوا طريقهم لدفن الجثّة، بعد أن اجتازوا حاجزًا خليطًا من المخابرات وأهالي أقليات فرعيّة.
لقد أضفى الكاتب على المشهدية ثراء وتسارعًا على أحداثها، إلى أنّ حلّ الظلام، ولم يعودوا يعرفون شيئًا عن الجثّة، و: [خافوا من اكتشاف أنّها تشوّهت إلى درجة موافقتهم على دفنها في أيّ حفرة، أو رميها لكلاب البراري الجائعة] ص62، وهنا يجد القارئ عودة الكاتب إلى التباطؤ في السرد، وتوقيفه في بعض من الحالات، تساوقًا مع ترسيمته الرئيسة الممثلة بالجثة؛ إذ هي الموت الساكن، العدم، التلاشي، ولعلّها هي التي حددت مقولة مركزية مهيمنة على خطاب النص بأكمله، قوامها مجاورة الأخوة للموت في زمن الحرب الظالمة ضد الشعب السوري.
عنون الكاتب الفصل الثاني بـ: باقة ورد تطفو على صفحة نهر، ولا تحتاج مشاهد البؤس المثيرة للشفقة، التي صورتها شخصيات هلعة ومرعوبة وعاجزة إلى مساحات زمنية واسعة في السرد، فالقارئ لا يحتاج لكثير جهد، حتّى يعرف شخوص القصّة المنكفئين نحو مصيبتهم المهيمنة على وجودهم، ولا يمكنه تخفيف انفعاله وجدانيًّا لاشتراكه بالمصير الصعب، لذلك لم يكن زمن السرد طويلًا لدى رواية الموت عمل شاق، ومن ثمّ لن يكون زمن القراءة طويلًا أيضًا.. وإن لجأ السارد، ليحكي عن الماضي، فهذا لترسيخ الرؤية وكشفها لمآسي حاضر الأحداث المفعمة بمآسي وطن محكوم للقهر منذ نصف قرن مضى.
وقد تمكّن الكاتب من إشراك القارئ الضمنيّ في صياغة نصّه، عن طريق حضوره في وعيه، في أثناء كتابته وقائع روايته، حيث عدّه أحد أعمدة البنية السردية، ولعلّ أدرك أنّه هو القارئ الذي لا يزال يعايش شخصيات الرواية، بل يشارك بالأحداث واقعًا معيشًا، ومن ثمّ تصبح قراءته منتجة، بمعنى أنّه استطاع أن يخلق: “القارئ الضمنيّ بصفته الذات الأخرى للقارئ الحقيقي، الذي يتخلّق وفقًا للقيم والأعراف الثقافية للمؤلف الضمني (المضمر في النص)” وهذا اقتدار الكاتب على وضع وقائع رحلة الموت الحاليّة بحالة مفهومة للمتلقي، لاسيّما أنّه اصطنع – لهذه الرحلة – خلفيّة حقيقية ماضية، وأيضًا أخذ بعين الاعتبار – هنا – إشراك القارئ برسم ملامحها التي عاش هو أو أحد أفراد أسرته في مجريات أحداثها في أثناء نصف قرن مضى، خالد خليفة يحاول أن يستثير عاطفة القارئ، تأييدًا للثورة السورية، ويدفعه للتأمل بما آلت إليه بلده، ويحفّزه لإعمال عقله واتخاذ موقف ضد القتلة والفاسدين والطائفيين والتكفيريين.
لا شيء أهمّ من واقعية الحدث لدى خالد خليفة في روايته الموت عمل شاق، ولكن حين تتحوّل أحداث الواقع المعيش إلى اللامعقول والأسطرة، لا يبق للكاتب سوى الفانتازيا المفعمة بتراجيديا قادرة على تصوير المآسي، وهل يوجد أكثر فانتازيةً من تصوير رحلة الموت التي عالجها؛ لدفن جثّة؟! هذا العراء، الذي يصفه السارد في أثناء الرحلة.. منظر الركّاب مثير للشفقة، أسمالهم فقيرة، يائسون، باصات تحطّم زجاجها وأمتعة مهجّرين بمئات الألوف نحو جهات مجهولة، كلّ ذلك خلفيات لمشاهد متتالية، البؤرة فيها جثّة تتفسخ، وتثير رائحة عفن الموت.
قارن بلبل بين لميا ابنة الثورة، التي جعلته يكتشف أن: [الحبّ باقة ورد تطفو على صفحة نهر]، وزوجته التي كانت تحمل رائحة بغيضة، وعاملته بدون اكتراث، و: [فكّر كثيرًا بأنّ المعنى الحقيقيّ للحبّ هو ما نفقده، وليس ما نعيشه] ص80، كانت الأفكار واضحة في عقل بلبل حينما التقى أباه؛ إذ أخبره – حينذاك – أنّه وزّع ثياب أمّه المتوفاة على من بقي من سكان، على الرغم من حصار مدينة س، وأخبره كيف استبدل ريحان الحبق بشجرات الزيتون الهرمة في حديقة منزله، وأخبره عن زواجه بنيفين.. مدرّسة الفنون التي رغب فيها منذ شبابه، وافترقا، ولكنّه تمكّن من عقد قرانه تحت ظلال الثورة بعد أن قتل ولديها، أولهما في مخابرات السلطة تحت التعذيب، والآخر برصاص المخابرات حين سعى مع الجيش الحر على دروب الانتقام.
إنّ استقراء أحداث الرواية الواقعة حاليًّا، التي يعيشها الكاتب بتفاصيلها في الزمن السرديّ، والمكتوي بنار صراع أفرقة الموت، وأكبرها السلطة، هو ما جعل صوت الكاتب أقوى من صوت السارد، ومن ثمّ لم يستطع إخفاء انحيازه للثورة، ظهر هذه الانحياز على ألسنة شخصيات الرواية، التي أملى الكاتب عليها مواقفه، فانتظم موضوع الرواية وفق رؤاه الإنسانيّة، واتسق مع معمارية النصّ المتسم بتكرار مشهدية الوقائع التي مرّت مع الأبناء الثلاثة على شكل ترسيمات متشابهة على امتداد النصّ وأحداثه.
يعود السارد بالقارئ نحو الخلف، نحو تخلّف مجتمع العنّابيّة، إذ شهد عبد اللطيف، الطفل احتراق أخته رفضًا لإجبارها على الزواج ممن لا ترغب فيه، ثمّ ينفتح السرد؛ ليحكي عن فقدان عبد اللطيف الشاب لنيفين الشابة، التي رغب فيها أيضًا، بعد أن تزوجت من صديقه في مدرسة س، ثم زواجه هو من هيام، ليلج وإياها مستنقع الحياة الزوجيّة والعائلة، ويتساءل القارئ مع السارد: هل كان وصول الأب عبد اللطيف إلى بيت ابنه بلبل المنفصل عن زوجته عزاء للابن عن فراقه لمحبوبته لميا، أو خلاصًا لروح رجل افتقد الحب عبر حياته؛ إذ: [حين يرحل الحبيب يأخذ معه مفاتيح السعادة، ويرميها في القبر…] ص91 ولكنّ الأب عبد اللطيف لم ييأس، أوصى ابنه بلبل بزوجته نيفين، ثمّ تلقّى منها هاتفًا طمأنته عن الثوار.
بات بلبل يتذكر أباه حين حلّ عليه ضيفًا، قادمًا من مدينة س، تذكّر كيف تجاهل الأب عبد اللطيف رأيه، حين قال له: إنّ الثورة انتهت وتحوّلت إلى حرب أهليّة، أهمله، وهمّ متحدثًا عن الشهداء والثورة، كانت ثقته برحيل الطاغيّة ونصر الثورة كبيرة، وكانت هذه الثقة تمنعه من سماع أيّ انتقاد، أراد أن يقول: [إنّ المجتمع الدوليّ وروسيا وأميركا والعرب موافقون على بقاء النّظام والقضاء على هذه الثورة التي وُلدت يتيمة…] ص91، ولكنّ بلبل يريد أن يعيش بسلام في حيّ مؤيد للسلطة، الحيّ المملوء بالميليشيات الشيعية، التي سلّحها النظّام وحزب الله، من السوريين والعراقيين واللبنانيين ومن أصحاب السوابق والعاطلين عن العمل.
يتذكّر بلبل كيف كان أباه يروي له عشرات القصص، عمّا يفعله النظام مع الناس، اعتقالات وقتل لمهربي الأغذية والأدوية لأحياء حمص المحاصرة، واغتصاب للفتيات لأيام عديدة وقتلهن وإجبار أهل الشهداء على الإقرار رسميًّا، بأنهم ماتوا في حادث سير مثلًا؛ مقابل تسليم جثامين أبنائهم، حدّه عن ازدياد الآباء، الذين نذروا حياتهم للانتقام بعد تهريب أسرهم خارج البلاد: [الورطة أكبر من احتمالها، تبادل الجميع الخوف، شعروا بالإعياء… إنها وطأة فكرة الانتقام، هرب الجميع خوفًا من الانتقام، كانت تكفي الشبهات؛ لترى الجثث مسحولة في الشوارع، أو الاختفاء من دون عودة، شيءٌ مخيف…] ص93، 94، يتذكر بلبل كيف رأى أباه عبد اللطيف – بعدما وصل إليه – كان عكس أبناء جيله، بدا أكثر شبابًا وقوّة، طاقة غريبة نبعت في أعماقه، كان يتحرّك مع شباب الثورة غير آبه بالموت، ومع كلّ تقدّم على درب الثورة، كان يتقدّم بحبّه لنيفين، التي لا تقلّ عنه نشاطًا مبتغيّة الانتقام لولديها، اللذين قتلهما النظام، كما كان يتخلّى عن كل ما يمتّ لماضيه بصلة، حتّى رائحة الماضي وأشيائه كان يطردها من ذاكرته، [… حقًّا، تحطّم جدار الخوف، عادت صورته، التي يحبّها كرجل شجاع، لا يخشى الموت، احتفظ بزجاجة سمّ قاتل لابتلاعها في حال اعتقاله، أما نيفين فقد بقيت للانتقام.. ولكن استمرار الحياة وهي تعيش وحيدة كانت هي المشكلة الكبرى، فكان لقاؤها مع عبد اللطيف، حيث تمكّنا في شتاء 2013 من طرد وحدتهما، توجّها إلى صديقهما الشيخ، وطلبا منه تزويجهما، وعاشا من أجل خدمة الثوار ومقابر الشهداء وحدائق الزهور والاهتمام بجرحى المشافي، كانا يسيران بهدوء ويريا: [القذائف تنهمر على البلدة، التي لن تقتل سوى الخوف…] ص107، لقد استطاع خليفة أن يصيغ تجربة إنسانية لشخصيتي نيفين وعبد اللطيف، بل يبتدعها بالكلمات، وبذلك اتفق مع فكرة النقد الموضوعاتي الذي عدّ: “الفن حسب المنظور الرومانسي ليس بناء شكليًّا بل قدرة على توليد تجربة ما وإنتاج معنى يؤثّر في الحياة” كان بلبل: [يفكّر وهو يستمع إلى أبيه، يظنّه يؤلّف حكاية غير حقيقية عن علاقته بنيفين ومدينته وثورته، لا يمكن لرجل مثله في السبعين من عمره ولامرأة تجاوزت الستين وأم لشهيدين الركض في الحقول وراء الفراشات، وكتابة رسائل حبّ يتبادلانها، كما لو كانا مسافرين،…] ص109، لقد راهن الكاتب على القارئ، فانعدمت المسافة بينهما، ولعلّ الدخول في مغامرة قراءة النصّ، ليست خارج المغامرة التي يعيشها القارئ بين صفوف الثوار بمواجهة أعتى الميليشيات المجرمة، كما أن تجربة الحياة في غضون زمن السرد تطابقت مع الموت الحاصل في كل لحظة من لحظات المسرودات في مبنى الرواية الحكائي، ومن السهل على القارئ أن يقف عند المدلول الذي يحتاج إلى قراءة موضوعية، وربما يهمل الاهتمام بصناعة النص والدوال الشكلية والبنية التعبيرية في الأسلوب Stilus سعيًا وراء تعرية تدريجية للمعنى المقصود، وهو إن كان غافيًا بين السطور، فإنّ راهنية الحكاية ومعايشتها، تجعل القارئ قادرًا على إيقاظه.
في أثناء رحلة الموت، تذكّر بلبل كيف أحبّ مناداته باسم بلبل بدلًا من نبيل الذي كاد ينساه، ولكنّه عاد من أحلامه أمام جثة أبيه، الحقيقة الوحيدة التي بقيت لأبيه، انتفاخها أعانهم على عبور الحواجز، وكانت البلدان والقرى التي يمرّون بها، لا توحي حركتها سوى بالموت والنزوح، قتال دائم وجثث مرميّة في العراء، ودبابات وآليات للجيش تحترق.
لم يهمل الكاتب مشهدًا من مشاهد الرواية في أثناء رحلة الموت على درب دفن الجثّة بماضي أبناء أبيهم، إلّا وربطه بماضيهم في بلدة س، وماضي عائلة الأب بالعنابيّة، فكشف عن عيوب الماضي النسقيّة المفعمة بوقائع أحداث الثورة، التي أظهرت استهتار نظام الحكم وجهله وطائفيته وفساده وإجرامه وعدميته إلى درجة الخيانة الوطنية، حينما سمح لقوى خارجيّة أن تقتل الشباب السوري وتهجرهم، ولعلّه استطاع أن يؤلّف بنية عميقة انتظمت فيها الأفكار واتسقت بوحدة نسقية منغلقة، تبدو كأنها انحرافات عن المدركات المألوفة التي قال عنها هولب: “إنّها الأشياء الفنيّة التي يتلقاها المتلقي والتي تستحق أن توصف بأنها فنية، وبالتالي فالإدراك والتلقي هما العنصران المكونان للفن وليس الإبداع والإنتاج” ، وهذا ما ينطوي نص الموت عمل شاق عليه؛ إذ لم يغب القارئ الضمني عن ذهن المؤلف من أجل منحه وسائل التفاعل مع أطروحاته وتجسيد أفق توقعاته المغروسة في بنية النص في أثناء زمن القراءة المفضية إلى تشييد نص محتمل محمل برؤى استشرافية.
انفتح السرد لماضي الأسرة، حينما كان حسين متفوقًا في المدرسة وقائدًا لفريق كرة القدم، وعازفًا على غيتار ومغامرًا مع زميلاته، إلى أن تعرّف على من تكبره بالعمر، فهجر دراسته قبل حصوله على الثانوية، واعتاد خدمة الأثرياء، فطرده أبوه من البيت، كونه تحوّل قوّادًا، ولكن حسين اتهم أباه بجهله؛ عما يجري في البلد من جرائم، وأوضح له خوف أبناء جيله وعجزهم، وهجر حسين بيت أهله؛ لينغمس في بؤر فساد السلطة، ومنذ تلك اللحظة، وحتى مرافقته جثمان أبيه الممدّد على كرسي الميكروباص، بقي في حيرة من جهله حالة أبيه، الذي لم يشكّ بتحرير فلسطين كاملة، هذا الرجل الذي غادر قريته قبل خمسين عامًا؛ بعدما بكى بصمت أخته التي انتحرت، وهو يراقبها من بعيد، ومن الملاحظ أنّ السارد الذي فوّض من قبل الكاتب، استبطن وعي شخصياته، ووصف أفعالها الخارجية، بل عرف نواياها، واطّلع على ما تفكّر فيه مع نفسها.
في الحرب لا تستطيع الإمساك بالموت ولا بالحياة، البهجة تموت والحبّ يموت، فـ: [الموت في الحرب أعمى لا يتأمّل ضحاياه…، وإذا كان بلبل قد رأى في الصباح الأشجار البعيدة قد استيقظت لتوّها، والتراب الندي على الجانبين، مما منحه شعورًا بالأمل] ص122، فلأنّهم شارفوا على الانتهاء من حواجز النظام، ويجد القارئ في المبنى السرديّ ملامح على درب الرواية الجديدة التي قيل فيها: “لم تعد علاقة الكلمات بأشياء العالم علاقة ارتداد مرآوي، بل أضحت علاقة استعلاء تباعديّ” ، ومن منظور الاستعلاء التباعدي بقي الموت مهيمنًا على فضاء الميكروباص طوال زمن السرد، حيث لم تعد تجدي روائح الكولونيا مع جثّة الأب، التي أزكمت أنوفهم.
استعاد بلبل أشهر الثورة الأولى، حين حضرت لميا، وطلبت منه التوجّه نحو بلدة س، للمشاركة في تظاهرة شباب الثورة، استعاد الذكرى، وهي تحتضن أباه، وتشكو له بلدتها ص الميتة التي تنتظر شرارة، يوم ذاك هتفوا للحرية في بلدة س، ورفع صوته مع أصوات أكثر من عشرين ألف شخص، وتذكّر كيف وصلت أكثر من عشرين سيارة مدجّجة بعناصر المخابرات والرشاشات، حين داهموا المظاهرة، وفتحوا النار على مسافة قريبة، وانسحبوا بعد إتمام المجزرة، ظلّت الجثث على الأرض، وشتم الناس النظام وأهله، أما الأب فقد: [ظلّ واقفًا، لم يتزحزح عن مكانه، كان يريد حصّته من الموت] ص125، كان يومًا عظيمًا عاشه الأب أكثر من ألف مرّة، واستذكر بلبل، كيف كان أهل الشهداء يسهرون قرب جثث أبنائهم! بينما دوريات الجيش والمخابرات تداهم البيوت، وتعتقل شباب البلدة، وكانت لميا ترى الجنود مذعورين لحظة فتحهم النّار على أناس عزّل، ولكنّها بقيت تهذي طوال الليل، بعد أن قُتل ستة شبان وامرأة من رشقات رصاص وجّهت إلى جنازة شهداء.. غادرت لميا وهي تشتم النظام بكلمات بذيئة.
بين تفكير كل من الشخصيات الثلاث، حسين وبلبل وفاطمة، وذكرياتهم أمام جثة أبيهم التي تتفسخ وتنتفخ ويكبر حجمها، ومع استدعاء شهود كالأب حين كان حيًّا، وزوجته الجديدة نيفين، ولميا من بلدة ص، كان يتوالد السرد؛ فتتداخل وجهات النظر أو تتعارض، ولكنّها تكمّل بعضها البعض بطرائق متباينة المضمون، موحدة في أدائها النفسيّ، لقد تحول السرد في بعض ساحاته مونولوجات داخلية للشخصيات الثلاث، وكانت: “عملية التداعي النفسي الحر هي التي استخدمها الكاتب، كما فعله كتّاب تيار الوعي بهدف تحديد تجاه وعي اشخصياتهم” ، التي جعلها خليفة بينهم، هجسهم لأنفسهم بماضي الجثة وحاضرها، والشعور بالخيبة تجاه المستقبل، ومن الواضح أنّ الكاتب أخذ بعين الاعتبار وجهة نظر القارئ من الأحداث، ومن ذلك أنّه حين اصطنع السارد فوّضه بترك فراغات في سياق النص، ليملأها القارئ، ومنها مثلًا: إشارته – ولو من بعيد – لقطّان بلدة ص أنّهم من أقليات دينية أعانوا نظام أقلوي مجرم، بل أذعنوا لإرهابه.
يبدو أن خالد خليفة، يكتب والقارئ حاضر في مخيلته، يشاركه في تشييد عالم التخييل، يكتب، فيتطابق في وعيه الخيال بالواقع، ولكنّه أنتج – بالنتيجة – سردًا عجائبيًّا، وهل هناك مؤلف يحمل مخيلة قادرة على بناء عالم الموت العجائبيّ، وصاحبه قابع في أحضانه؟! إنّه خالد خليفة الذي لم يتوانى لحظة على تحميل روايته مقولات تؤكّد على واقع الموت، وها هو ذا بلبل يحاول أن يخرج من ذكرياته، فتمنّى أن يصلوا إلى العنابيّة؛ ليدفن أبيه ويغتسل من الماضي دفعة واحدة، الماضي المتعلّق بالأب، الذي لم يتمكّن من قتله في داخله، عاش فيه واستكان لطغيانه، إلى أن استحال جثّة تنتظره؛ ليواريها ظلمة القبر مؤكّدًا أعباء الأبوة البطريركية على الأبناء.. أتكون نهاية للدرب، أم بداية جديدة؟
ولم يكن حسين الذي حاول قتل أبيه في داخله، بأحسن حال من بلبل، فقد ارتمى بأحضان أبوة سلطة الموت وفسادها، ونشأ داخل قيم مجتمع بطريركي، وتحوّل إلى مستهتر وعبثيّ.
على درب الموت، تهيّأ حسين مع أخويه لمواجهة حاجز النظام الأخير، الذي أوقفهم بعد أن حجز الضابط أوراقهم، ثم قال حسين فاقدًا أعصابه: [بعد ساعات سنموت من البرد أو من رائحة الجثّة،…] ص131، ولكنّه شرع في الغناء بمواجهة العبث، الذي يعايشونه، وضاعت مهابة الموت.
كان لباس العناصر وعصبات رؤوسهم على الحاجز تشي بانتماء طائفيّ، أعلام حزب الله وفصائل شيعيّة عراقيّة وفصائل أسسها النظام للقتال، كانوا غير منضبطين… وكانوا قد نشروا القبور الجماعيّة في كل المدن…] ص133.. أمّا جثّة الأب فتشوّهت، ومساماتها تفكّكت، وعناصر الحاجز – الثكنة، متأهبون للقتل ، وزاد الأمر سوءًا أنّ العاصفة قادمة.
تُرى، أين وصلت هتافات شباب الثورة التي اخترقت أبواب السماء مطالبة بالكرامة والحريّة؟ هل ضاعت أمام اصطفافات طائفيّة جديدة؟ أيكون النظام نجح بتحويل الثورة إلى حرب أهليّة على ما رفض بلبل سماعه من فم الأب من قبل؟ أسئلة تطرح في سياق نص خليفة وكأنّه ابتغى مخاطبة قارئًا فعليًّا” ؛ إذ جعل بلبل يسائل نفسه، واختلفت الرؤيّة، حين استحضرت ذاكرته على درب الموت وقائع ميادين الثورة، ففي المرحلة الأولى من عمر الثورة تمكّنت النساء من انتزاع حقّهن، ونزلن إلى الشوارع وطالبن بالحرية إلى جانب شباب، نذروا أرواحهم قرابين على مذبح الحرية، وتطهر كثيرٌ من الذين لوّث سلوكهم النظام بالفساد المالي، والدخول بعالم السمسرة والعقارات والدعارة والمخدرات، لاسيّما في بلدات س العديدة.. تُرى.. إلى متى سيستمرّ النظام في تلويث شرف مناطق الأقليات بموبقاته، التي لم تعد خافيّة على أحد؟! هل يستجيب التاريخ للنظام الذي سقط تاريخيًّا واستحال جثّة هامدة، أم أنّ التاريخ سيفتح ذراعيه لشباب يبثّون فيه الحياة من جديد؟
تجاوزوا الحاجز، ومن جديد غرق بلبل بماضيه حين درس الفلسفة، وتحوّل إلى موظّف يخاف من أيّ شيء، وتذكّر لميا، وهي تؤكّد عليه ضرورة الثورة على التخلف والديكتاتورية، ثورة لمحاسبة القتلة، ثمّ وجدوا سيارتهم وحيدة في طريق مظلم، نسوا الجثّة، لأنّهم علقوا في فخّ المجهول.. وما أدراك ما المجهول؟! وما المعادل له في حياة الثورة؟ هذا الضياع الذي ابتغاه المؤلّف معادلًا لجهل بقيّة في ربقة فكر سياسي حداثوي متخلّف، المجهول المعادل تضليل المتثاقفين والساسة لأهل الثورة، ولكن هل سيستمر هذا الضياع في أفخاخ المجهول؟
بعد تيه في مجهول الظلام لمحوا أضواء اتجهوا نحوها، ووجدوا حاجزًا لجنود جيش النظام، فقراء، وضعوهم فيه؛ ليستقبلوا الموت، وعندما نظروا إلى هوياتهم عرفوا قريتهم، ترحّموا على الميت، واتصلوا بحاجز الجيش الحر التالي، لأنّ فيه أقارب لهم، وقبلما تجاوزوا الحاجز التالي، نبّهوهم من كتائب متشدّدة لها أنظمة خاصّة في الحواجز القادمة.
رافقهم شعور الطمأنينة في الساعات الأخيرة، حينما وصلوا إلى المناطق المحررة، لم تعد هوياتهم مشكلة، فهوياتهم ارتبطت بالعنابية وبلدة س، وهما تنتميان إلى الثورة، وأبناء الثورة في كلّ مكان، كما كان يقول الأب حين كان حيًّا، هكذا قال بلبل في سرّه، وكان فخورًا بتنفيذ وصية أبيه، عندما اتجهوا نحو المدفن، الذي طلب دفنه فيه.
في سيارتهم التي أطفأوا أنوارها نزولًا عند أوامر سيارة للثوار، فكر بلبل بأمّه، ثمّ تداعت ذكرياته مع أبيه من جديد، وإخبارهم عن العنّابيّة وعن أهله وعن المقدم جميل ابن عمّه، الذي قام بمحاولة انقلاب، وكاد أن يكون رئيس جمهورية، مات الجميع الآن، ولم يبق إلّا بعض أبناء عمومة في مخيمات تركيا، أو في المعتقلات أو مقاتلين في الجيش الحرّ، وقلة في العنّابيّة تعبوا من دفن أمواتهم خلال السنوات الأربع الماضيّة.
ثمّ نبهّت فاطمة أخويها إلى الجثة المفتوقة، ولكنّ: [حسين قال غاضبًا لتتحول إلى خراء، شتم أباه والعائلة…] ص149 وتاهوا من جديد في العتم، حتّى وصلوا إلى حاجز لغرباء، قادوهم إلى مبنى الأمير، وهناك دخلوا إلى مملكة الأقنعة، وبدأ الأمير يخطب فيهم بلغة عربية فصيحة مضحكة تشير لجنسيته الأفغانية أو الشيشيانيّة… ثم غادروا بعد انهمار عشرات القذائف قرب المكان، ولحظة منتصف الليل أطفأ حسين محرّك الميكروباص، واستكانوا: [لا أحد يريد النظر إلى الجثّة، أصبحت وباءً وفقدت بريقها،… تنفسوا موت أبيهم، كما لم يتنفس أحد موت حبيب… ما بقي منه حقيقته الوحيدة: بعض عفن وقروح…] ص154، وعندما حاولوا تحريك الجثة، هاجمتهم الكلاب الجائعة الشرسة؛ فأغلقوا أبواب الميكروباص، وبدأ بلبل يشعر برعب من: [جيفة تثير شهيّة الكلاب المسعورة] ص157، ثم ضاعوا في العراء، ولم يتذكّر بلبل سوى الكلاب الشاردة، التي هاجرت من ريف دمشق نحو قلب المدينة، وحكت عن جثث التهمتها بعد المعارك الكبرى، كانت قد تذوّقت طعم لحم البشر، ولن تستطيع أن تنساه.. أما حسين فتذكر طرد أبيه له من البيت، وشرع في رمي الجثة إلى العراء، ولكن بلبل شعر بقدرته على القتل، ثم لكم حسين، الذي تمكن بعد ذلك من توجيه ضربات لوجه بلبل وسط بكاء فاطمة.
أحداث متلاحقة عالجها خالد خليفة، أظهر معانيها السطحية، ولكنّ الكثير من المعاني العميقة خلف السطح، يستدلّ عليها بالقراءة، مثل: الجثة المفتوقة التي جعلت حسين يستدعي مفهوم تسلط الأب الذكوري، والتيه في العتم، عتم الرؤى في حضرة أمراء الظلام الذين يتصارعون مع سلطة الطائفة، تنفسهم الموت وسط كلاب مسعورة استدعت كلاب الغوطة المتخمة من جثامين القتلى، ولابد أن يعي القارئ هدفه في أثناء القراءة؛ لكشف البنى وتعرية المعاني العميقة، التي: “تتعلق بالمعنى الخفي للوجود (الإبداع)، والمعنى الخفي للعمل الإبداعي (النقد) وإذا كانت مهمة الشعر أن يكشف عن المعنى الخفي للوجود، فإنّ مهمة النقد أن يكشف عن المعنى الخفي للعمل الإبداعي” وقد لا يحتاج نصّ خليفة إلى ناقد يوقظ المعاني الغافية بين السطور في سباتها، وذلك على سبيل المثال حين يكمل: وبعد حين أوصلهم حسين إلى قرية منكوبة ومدمرة ومهجورة؛ ثمّ إلى منزل وسط الدمار، يعيش فيه زوجان عجوزان، فكّر حسين بدفن جثة أبيه، ولكن العجوز أخبرته أنّ لا مكان لدفن جثث جديدة، إذ فاضت القبور على موتاها، وبقيت أكثر من مئة جثّة مرميّة في الطرقات، لعلّ القارئ يستشعر تلقائيًّا اهتمام خليفة بالمكان؛ إذ جعل: “المناظر الطبيعية في الفانتازيا ليست فقط خلفية للأحداث، بل لها دور كأدوار الشخصيات” وهكذا كان داخل الميكروباص الذي نام حسين وبلبل فيه، فحاولت فاطمة مسح جثة أبيها، ولكنها فشلت أمام الشقوق التي تنزّ قيحًا كالخراء، فالمكان هنا تحوّل إلى بطل العمل السرديّ.
تذكّر بلبل قصة حب أبيهم مع نيفين، التي شهد المستشفى الميداني وقائعها، وتذّكر كيف تمّ نقل العيادة الطبية إلى قبو بعد إفراغه في منزل نيفين، التي فقدت زوجها قبل سنوات، ثمّ كيف استقبلت جثة ابنها في كيس أسود بعد قتله في معتقلات النظام؛ نتيجة رصاصة في الرأس، أطلقت من الخلف، وكيف طلبت من زملائه الأطباء تجميع اعضائه، ولكنّها قبلت أخيرًا بدفنه على هيئته، إذ: [كثيرون دفنوا ما بقي من أبنائهم، ولم يحصلوا على جثة كاملة…] ص167، ولكنّها تأمّلت جثمانه، وأرادت أن يصل حقدها إلى مداه الأقصى.
إنّ خليفة قدّم مشاهد روايته كما لو كان في عين عدسة كاميرا السينما، المرتكزة على: “المونتاج المكاني الذي يغيّر العناصر المكانية ويبقي الزمن ثابتًا، أو المونتاج الزمني الذي يبقي الشخص ثابتًا في المكان، ويتحرك وعيه في أزمنة متعددة” فتداخلت الصور المتحركة والذكريات وقصصها، وتوالت سريعًا، وامتدت إلى اللانهائية، كان يكتب كمن يقوم بمونتاج سينمائي، يطابق بين صور داخل الميكروباص، وصور خارجه، فيحيط إحداها بالأخرى، أو يثبت إحداثها ويحرّك أخرى، وهذا التكنيك متعلق أولًا وأخيرًا بتقنيات تيار الوعي، الذي يجمع المؤلف بين الحياتين الداخلية والخارجية في زمن مشترك.
بعودة السارد خطفًا إلى الخلف، ليتذكّر ربيع 2012 الذي اشتدت فيه المعارك مع نظام اختار درب الطائفية المسلّحة لمواجهة المتظاهرين، حيث كثر المسلحون، وانتصرت أجنحة المسلحين على أنصار الثورة السلميّة، فصار شبح الموت يحوم فوق كلّ البيوت، ترك الطلاب مدارسهم وجامعاتهم، والناس حياتهم السابقة، وانضموا إلى الجيش الحرّ، وبدأت تظهر أرتال المهجّرين، ثم مات ابن نيفين الثاني في درعا، الذي رفض أوامر النظام قتل المتظاهرين من دون تمييز بين طفل أو امرأة أو عجوز، ففضل القتال مع جيش الثورة ضد جيش النظام حتى الرمق الأخير.. واستشهد، عرفت نيفين أخيرًا، وهي تجول بين الدمار، بأنّ ما حدث ضرورة وواجبًا، هو نتيجة لـ: [سيرة طبيعيّة للوهم الذي عاشه الجميع، الوهم بحياة في أزمنة العار، والصمت الذي عاشوه سنوات طويلة يجري الآن دفع ثمنها، الجلّاد والضحيّة، تصحيح خطأ الحياة المنافقة…] ص173، لم تكن نيفين تريد سوى رؤية جلّادي ابنيها أذلاء وخائفين، وهي في انتظار موتها.
لقد شكّلت أحداث هذا الفصل مع أحداث الرواية الأخرى وحدة نسقية واحدة، أضفى الكاتب عليها طابع الموت، وجعله بمرتبة الاستعارة الكبرى، الموت الذي ارتبط مع ميليشيات مجرمة متقاتلة بشكل وحشيّ، ولم يكن السارد بحاجة؛ ليحوّل السرد من متخيل إلى واقعي أو إلى افتراضي، لأنّ الكاتب أخضع سرديته لمكان منغلق وزمان محدد، فيهما ما يكفي للشروع في مغامرة الكتابة الروائية مكتملة البنية من دون اللجوء لتحولات سردية، ولكنّه اهتمّ بالنمو الاستعاري عن طريق تكرار الوقائع المتشابهة والمتعالقة مع الموت، ولعلّ الفضاء الروائي الذي انغلق على سيارة الجثة مع أبناء صاحبها، مع انفتاح السرد على أماكن تتصل بالجثمان الذي يشكل عبئًا على مرافقيه، وكأنّ بيده كاميرا سينمائية، فيسلط عدستها على الحواجز والقرى المهدمة وأماكن تواجد المهجرين والمقبرة… وقد يقتطع مقفًا من مشهد، أو يقرب العدسة لإظهار ملامح ضابط مرتشٍ أو شيخ جاهل، أو منظر الجثة التي تنتفخ وتنز قيحًا، أو… ثم يجعل شخوصه الثلاث ترتد إلى الماضي ويمزجه بالحاضر، ولعله لم يرد أن يهتم بالمضمون الذهنيّ، واستعاض عنه بالشروط السيكولوجية للشخصيات، إذ إنّ: “الأحداث الرئيسة والقصة الأساسية تحدثان في أذهان الشخصيات” لعل فضاء الرواية الذي اهتمّ الكاتب برسم ملامحه وتكثيف دلالاته؛ حتّى جعله بؤرة فعله السرديّ، قلل من اهتمامه بوصف الشخوص والأحداث خارج الميكروباص، حتى كادت الجثة وفضائها المنغلق يكونا بطل العمل الروائي الفذ، الذي قدّمه لنا خالد خليفة.
عنون الكاتب الفصل الثالث، بـ: بلبل الذي يطير في مكان ضيّق، واستهلّه بلحظات اقتراب وصولهم لدفن جثة أبيهم؛ إذ سمعوا أرواحًا تئنّ تحت الركام، ورأوا ملابس الموتى الممزقة وأشلاءهم وهياكل عظمية، رأوا خرابًا عظيمًا، عرفوا أنهم سيصلون بعد ساعتين، وأن القبر يحتاج إلى جثّة حتّى يكتمل، ولم يهتموا لفقدانهم القدرة على الاتصال من موبايلاتهم الفارغة، فأبراج الاتصالات مدمرة، حتى لو توفّر الاتصال لهم، فهم لايعرفون أرقام موبايلات أحدٍ، ما يربطهم بالوجود في تلك اللحظة هو الجثّة، التي [لم تعد تعني لهم أيّ شيء، يستطيعون تقديمها لجوقة كلاب جائعة من دون أيّ إحساس بالندم، أو رميها على قارعة الطريق من دون ستر ندوبها،… إنّ إهمال أولاده وقلّة حيلتهم كانا سبب تفسّخها، لقد حملوا وباءً يجب تطويق انتشاره، الوباء الذي ساعدهم في العبور السريع] ص178، ولكن إلى أين؟ إلى العنابيّة.. إلى مقبرتها، وهل هي قادرة أن تستوعب موتًا جديدًا؟!
ولكنهم شعروا أنهم كلما اقتربوا من محطة دفن الجثّة ساعدتهم بطاقة هوياتهم، فكل الناس على المرور أقرباء، لم يغادروا خيام القبيلة المحافظة على عصبيتها.. ولكن هل شباب الثورة وقعوا في أفخاخ القبيلة والطائفة والتكفير والحزب، وحملوها بصفتها جثامين متفسخة تحتاج إلى الدفن؟ وهل هي معادل لحمولات نظام السلطة الطائفيّة منذ نصف قرن مضى؟ السلطة التي وجدت من يمنع تراكم جثامينها المتهالكة، التي تحمل كلّ تلك الديدان، من شبيحة وتكفيريين وطائفيين كريهين، السابحة في فضاء سوريا، الناخرة كحشرات سامة في جسد ثورة شباب.. هل فتح التاريخ ذراعيه للثوار؟ كيف ستكون ملاقاة العنابية لميكروباص الجثّة؟
تمنى بلبل لو يستحم ويغسل جسده من كل رائحة، رائحة الجثّة والعائلة والثورة والنظام، فقد أحلامه، وعلق في شباك النسيان، فقد لميا، وفقد سكنه – بيت الزوجية – الذي لم يحبّ الموت فيه، فكان هجرانه له؛ إذ لم يبق له معنى مع زوجة تعدّ الجنس وسيلة تواصل أكثر منه لذة لامتناهية يتوجب رشفها ببطء وقوّة.. هو الذي قضى حياته بعزلة، احتسى خمورًا رديئة، وتناول طعامًا بائتًا، وخاف من كلّ شيء، كأنّه: [معلّق في مسمار السماء الصدئ، لا يستطيع الهبوط على الأرض وعاجز عن الطيران] ص182، مواقف بمرتبة الكوابيس كان يمرّ بها بلبل في أثناء رحلة الموت، مرّ الزمن من دون أن ينتبه، كان وجوده يوازي عدمه، كان يتماوت، ولكنّه انتصر على دفن بقاياه.
الآن، يحمل قلبًا، يزداد انقباضًا كلما اقتربوا من العنّابيّة، ما الذي سيجده قرب قبر عمته، التي حرقت نفسها انتحارًا؛ لتمنع إجبارها على الزواج ممن لا تحبّ، وخاطب جثمان أبيه بسرّه: [من الصعب رؤية خوائك بعد نصف قرن من الوهم، تعود كتلة متفسّخة تنبعث منك روائح بشعة، وتتناسل الديدان من خاصرتك…] ص185، و: “موضوع حلم اليقظة شائع في النقد الموضوعاتي… وغايته إبراز بعض البنى، والكشف التدريجي عن المعنى” ، وقد استطاع خليفة أن يوظّف أحلام شخوصه الثلاثة، بل كوابيسهم التي أنهكتهم في يقظتهم، والكشف عما يريد قوله بدلالة جثة الأب، ونجد بلبل يستمر منشغلًا بمناجاة كابوسية، عن أبيه الذي لم يكن من أهل نظام السوء، ولكنّه عاش في كنفه، وسكت عن جرائمه خانعًا مع أبناء جيله.
اختبر الأب أبناءه على دروب الموت، ساروا في دروب متعرّجة، واستغرقت رحلتهم ثلاثة أيام متواصلة بدلًا من ثلاث ساعات في الأحوال العادية، هامات بشر وسلوك متوحّش، حواجز مخابرات النظام الفاسد والتكفيريين والطائفيين مزروعة على طول الطريق، كان الأخوان يتساءلان عن عراكهما، فيما لو طهّرهما من الماضي، وتمنيّا لو بقيا طفلين، لحظة خاف أحدهما من الآخر، أمّا فاطمة ارتعبت من اليتم الحقيقي، عندما فكّرت باقترابها من العنابية، لاسيّما عندما فاحت رائحة الموت الطازج والمقابر الجماعيّة والدمار واتشاح القرى بالسواد، مما دفعهم للنسيان؛ ليخلصوا من هذا الكابوس، إنّ موضوع رواية خليفة هو الموت الذي لم يغب لحظة عن فضاء الرواية فـ: [التيمة مكررة طوال العمل، وعملت وفق نظام محكم، وموضوع الموت لم يكن محايدًا أبدًا] ، واستطاع السارد Narrator أن يجعل من: “كلّ العناصر الخطابية مسهمة في بلورة التيمة الكبرى للنص” مروا بحاجز، فسهّل مرورهم لقرابة أحد عناصره بالجثة، ومهّد لمرورهم بالحاجز التالي، وحذّرهم من حاجز المقاتلين المتشددين الذين يزعجون المسافرين، وكانت لهم مصيبة مع التكفيريين من جديد.
هجر أبناء القرية منازلهم، وكانوا يعودون إليها جثثًا، ليستقبلهم شقيق الجثة الذي تجاوز الثمانين من عمره، ويقرأ عليهم الفاتحة ويسهم في دفنهم، وتنطبق مشاهد الموت والكلام عنه وتكراره في متن القصة بمفهوم التجانس الذي: “يتجلى في رسم مجموعة العناصر المعروضة للدراسة كنظام متسق ذي خصوصية…” حيث اتسق مفهوم الموت طوال زمن السرد، وكان الأخوة الثلاثة ينتظرون انفجار الجثّة بعد احتمالهم عناء السفر لثلاثة أيام، لم تعد تصلح للوداع، أزكمت أنوفهم وما تحتاجه صلاة سريعة وحفنة من تراب، تمامًا كما يحتاجه نظام الحكم، الذي استحال جثّة، فتدخلّ العالم ليمنع دفنها، فتوالدت ديدان جثته المرماة بين الناس مئات ميليشيات الموت الطائفي والتكفيري.
وكلما كان أبناء الجثة يتقدمون، كانت الجثث تتزايد والأعلام السوداء ترتفع فوق المباني، حتى وصلوا إلى حاجز، أجبروا على السير ببطء، وفخروا عندما قالوا أنهم من بلدة س، وأصولهم من العنابية، ثم قادوهم مقيّدين معصوبي العينين نحو غرفة فيها مقنّع قلّب بهوياتهم، واستجوبهم عن أمور دينهم، وأبلغوهم ان أباهم كان بعثيًّا، ويعرفون عن قريبهم المقدّم جميل، وبعد أن قادوهم إلى القاضي الشرعي عرفه حسين، كان من أبناء قريته على الرغم من قناعه، عرفه من لهجته، وفي المحكمة الشرعيّة رموا بلبل في زنزانة لتعليمه الدين، أما حسين فاجتاز الامتحان، وخرج من المبنى بعد خمس ساعات مرعبة من التحقيق، ليجد فاطمة قد أصيبت بالخرس، داخل الحيز المكاني الرئيس لأحداث الرواية، داخل الميكرو باص، المكان الذي اختاره خليفة ببراعة ليعبّر عن أحوال الموت في سوريا، حيث لا أحد يستطيع أن يكون خارج حيّز، فالحيز هو حياة الأديب ومضطرب خياله ومجال آماله ومنتهى أحلامه، وفق ما ذكره مرتاض، و: “كأنّ المكان عبقريته، وكأنّ عبقرية الأدب، حقًا، حيزه، فكأنّ الحيز، إذن، هو الذي يجسد عبقرية الأدب” ، وحين افتقاد الآمال وانكسار الأحلام لم يبق لخليفة وشخصية روايته فاطمة التي انتظرت داخل ميكرو الباص ساعات بجانب الجثة حتى أفرجوا عن أخيها وجاءها فـ: [أشارت بإصبعها إلى جثّة أبيها التي تتناسل الديدان منها بكثافة] ص93، فغادر المكان هاربًا من التهام الديدان لهم، [الديدان تناسلت بأعداد هائلة، لم تعد السيطرة عليها ممكنة، تسلقت نوافذ الميكروباص، غطت المقاعد،… استسلمت فاطمة لعالمها الجديد] ص194، ليكون الحيز الذي اختاره الكاتب مجسدًا لعبقرية المكان في رواية الموت عمل شاق، أما حسين فشعر بسخافة حمل جثمان أبيه هذه المسافة إلى قرى مدمرة وأرض أزهر فيها الموت.
وأخيرًا وصل أبناء عمومتهم صدموا من تناسل الديدان التي تحاول التهام فاطمة المستسلمة لهم، فطلبوا منها الانتقال إلى سيارة أخرى، ثم تدبروا أمر فك أسر بلبل، وصلوا إلى العنابية، وهناك قرروا أن يكون الدفن بعد صلاة الفجر قبل وصول غارات الطيران، أخبر بلبل عمه بوصية أبيه أن يدفن في قبر أخته ليلى، ولكن العم آثر دفنه في قبر أمّه تنفيذًا لوصيتها قبل 40 سنة، أمّا الشاب المسلّح فاعتبر الوصايا ترفًا ودفن جثّة عمه ضائعًا في زحمة القبور، فـ: [بقيت ليلى، الأخت التي حرقت نفسها، منفرّدة، بعيدة، منبوذة، تحيط بقبرها مساحة كبيرة فارغة، كلّ فترة يغرس فتية مجهولون أشجار ورد صغيرة فيها سرعان ما تذبل وتموت، بقيت سيرتها حيّة على الرغم من محاولات العائلة طمسها، الحكايات هنا تتحول وتُروى بطرق جديدة لكنّها لا تموت] ص197، وحينما حاول حسين أن يأخذ غفوة، استيقظ على أصوات الرصاص، التي تعلن عن وصول جثث جديدة من أهل العنابية، أما بلبل الذي بقي بين يدي التكفيريين، ففكر بأنّه سيموت قريبًا في زنزانة موت الدروس الدينية، ثمّ استحضر الماضي، واستغرب كيف طالب جموع المؤيدين للنظام ببطش أكبر على الرغم من جرائمه، التي حوّلت المتظاهرين إلى مقاتلين؛ يهللون لقتل المؤيدين وذبحهم، [كان بلبل يفكّر بصمت ويتساءل ماذا تفعل بنصر يرشح دمًا] ص199، لم يحتمل بلبل الحياة وسط طوفان بشر رأوا في الموت حلًّا نهائيًّا؛ لمعضلة الحياة، يستحضرون ثارات من أعماق التاريخ لتبرير القتل، لم يعد يحتمل الحياة، وهو يستذكر مذيعات متبرّجات، ومحللين كانوا يغطون شاشات التلفزة السورية؛ ليشرحوا تأثير الحبوب المخدّرة على المتظاهرين وتقاضيهم سندويش كباب ومائة ليرة؛ لتنفيذ مؤامرة قلب نظام الحكم، كان بلبل يتذكّر، ويغمس رأسه مع عشرين آخرين، ليتعلّم الصلاة بقوة السلاح بشكل عبثي، اطمأن عندما فكّر أن جثة أبيه تعانق جثة أخته ليلى بقبرها.. هي التي حرقت نفسها يوم عرسها لتكون رسالة لهم عن موتهم الشاهد على تاريخ نصف قرن ملوّث بدماء السوريين.
إنّ خليفة رسم ملامح شخصياته خارج النمطية، بل جعلها مضطربة، وقلقة، ساعية لمعرفة المعاني القريبة، وليس معانيها البعيدة، ولم يخرج وعيها عن نطاق الوعي الفرديّ المستقل عن الفعل، هذه الشخصية هي ما اشتغل عليه كتاب تيار الوعي منذ اوائل القرن العشرين، وإذا تتبعنا شخصية بلبل مثلًا الذي حلّ بين أهله أخيرًا، الذين أصبحوا ينادونه باسمه نبيل، وليس بلبل، كما سمّته لميا حين كان طالبًا.. كانت عيناه زائغتين تومئان لجنونه، ويداه ترتجفان، ولحظة وصوله بكت فاطمة، واحتضنته وحاولت أن تستعيد صوتها للمرة الأخيرة، ولكنّها فشلت، لقد تمكّن منها الخرس تمامًا، حسدها نبيل على صمتها الأبدي، وشعر بألم من تجاهل أخيه حسين له، وبعدما نام حلم بأنّه يطير في مكان ضيّق، وحين الفجر توجّه لزيارة قبر أبيه، وعرف أنّه دفن بعيدًا عن قبر أخته ليلى، فـ: [عمّته لم تكن ترغب في مشاركة أحد من عائلتها قبرها، تريد قبرًا متفرّدًا لا أحد يجرؤ على النوم فيه سواها] ص204، عمّته ليلى التي أبت العيش ذليلة، فانتحرت، وذكر بهذا الصدد: “أن الوعي في مستويات مرحلة ما قبل الكلام لا قالب له، ذلك أن الوعي بطبيعته يوجد مستقلًا عن الفعل…” يقرأ المرء الشخصيات، ويستشعر أنّ الوعي الذي يتحلى فيه بلبل وأخته وأخيه لا قالب له، وكأنّ عقولهم ووعيهم ورؤاهم مستقلة عن أفعالهم.
عبر بلبل الحدود إلى تركيا، وأمام جموع المهجّرين شعر باشتياق لبيته ومكتب وظيفته، على الرغم من خوفه من الفاشيين، الذين ظلّوا يرفعون البنادق من أهل النظام على أمثاله.. رجع إلى العنّابيّة، ومنها عاد من حيث أتى، رجع، وكان اليوم الأخير من رحلة الموت، رجع الأخوة الثلاثة إلى دمشق من دون جثمان أبيهم، رجعوا وهم متوجسون من درب الانكسار، أضحت فاطمة خرساء، وبات حسين يتجاهل بلبل طوال طريق عودتهم.
أمام بوابة دمشق، ودّع بلبل أخيه من دون أن ينبس بأيّة كلمة، وصل إلى بيته، كانت رائحة أبيه تزكم أنفه، حاول نسيانها، قبع في الظلام، وشعر بأنّه وحيد، ولكنّه قرر ألّا يسمح لأحد بمناداته سوى باسمه الأصلي نبيل، على عكس ما اعتاد أن يسمعه من لميا وأقرانها، ولكنّه بقي يشعر أن الكلاب لا تزال تنهش به كونه صار جيفة أيضًا، بعدها اندسّ في فراشه، وعرف أنّه جرذ كبير لا لزوم لوجوده.
اقتدار جماليّ وضح في نسج حبكة رئيسة منذ بداية أحداث الرواية وحتّى نهايتها، حبكة مستمرّة، انتقل عبرها الكاتب من تكثيف إلى آخر من دون توقّف، وإن كان قد نسج حبكات فرعيّة فغالبيتها بسيطة، نسجها في أثناء توقّف الميكرو باص على الحواجز العسكريّة، مؤجّلًا دفن تلك الجثة المسبّبة لهذا القدر الكبير من معايشة الموت.. لقد استطاع خالد خليفة أن يخلق من نصّه الإبداعيّ وحدة متكاملة بين الدال والمدلول؛ فأثار لدى القارئ مزيدًا من التوتر تساوقًا مع توتر الشخوص المحيطة بالجثة، وذلك لتدعيم واقع العدم الذي يعيشه السوريون، بل أشرك القارئ بفعل الكتابة مفعمًا نصّه بالدوال والصور، و: “التص الذي يشارك القارئ في كتابته Writerly، يمثل تفاعل الدلالت تفاعلًا حرًّا من دون حدود، ويتضمن النصّ – حينئذ – كوكبة من الدوال المانحة النص مدلولاته، حتى تغدو الشفرات التي يحشدها تمتد إلى آخر مرمى البصر” كما اشتغل على الخطف خلفًا؛ ليكشف عن ماضٍ مأساويٍّ أدّى إلى زمن الجثّة المتفسّخة، لقد احتاج خليفة أن يستدعي الماضي بمدلولات الواقع المأساوي، وحبك معمارية أحداث نصّه السرديّ المستمرة ارتكازًا على مبدأ العلّية، وأقفلها على أحداث موجّهة لخرس فاطمة وللجثة والمقبرة ومشاهد الموت في القرية والتهجير في الشمال، وصمت رهيب داخل الميكروباص في درب الرجوع، التي انتهت بافتراق الأشقاء، ثمّ كان يصطنع حبكات فرعيّة بهدف المراوحة في الزمن Time؛ رجوعًا نحو الماضي المتسم بالسكون، وتقدّمًا نحو الحاضر المفعم بالحركة، ولكنها حركة حول جثّة تهترئ مع كل لحظة سردية.
وأخيرًا، لم يكن لدى الكاتب إمكانية تطوير شخوصه، بل قدّمها إشكالية ومأزومة أمام وجود انغلق على الموت، واستطاع تبئيرها كونها ساكنة مع الجثة، كما أنّ أحداث الرواية اكتسبت صفات الموت، الذي لا يعرف التغيير، حتّى أضحى استعارة كبرى عن أحداث حرب ظالمة يعيشها السوريون، لقد استغرق زمن السرد ثلاثة أيام من لحظة خروج ميكرو باص حسين محمّلًا بالجثة حتى لحظة دفنها، إضافة إلى ساعات درب العودة، من الشمال المفعم بالموت، إلى دمشق المحمّلة بالموت أيضًا، وهكذا خرست فاطمة، وربما جنّ بلبل، وابتعد حسين وحيدًا، نهاية لم يخرجها عن الفضاء الزمكاني للرواية، عودة لمناطق سيطرة نظام الموت، وامتداد لأحوال القهر والجهل والخوف الممتدة منذ نحو نصف قرن مضى.
نشرت على الحوار المتمدن هنا