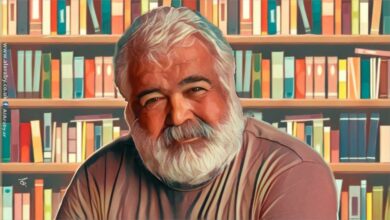كلكم تعرفون خالد خليفة. أليس كذلك؟
الكاتب الشهير ذو الشعر الأشيب والجبين المتغضن والجسد المنهك جراء ساعات الجلوس الطويلة وراء طاولة الكتابة.
لكنكم لم تعرفوه عندما دخل علينا في ذلك الصيف البعيد إلى خيمة التدريب العسكري الجامعي. شاباً فتياً ذا جسد منحوت كجذع سنديان، وسمرة جذابة لونتها جبال عفرين وحقولها، بشاربين أسودين معقوفين كنسر متأهب. لحسن حظي انتقى حينها السرير المقابل لي على طرف الخيمة. نفض عنه الغبار بقبعته العسكرية واستلقى عليه. سهى بضع لحظات ثم مدّ يده إلى جعبته ساحباً منها كتاباً وبدأ يقرأ. وبحركة لا شعورية مني قمت بسحب كتاب من تحت مخدتي وبدأت بالقراءة. هنيهات .. أزحت الكتاب من أمام وجهي لأراه ينظر لي مبتسماً بتلك الابتسامة الساحرة التي تنتفخ فيها وجنتاه وتضيق بها عيناه لدرجة الاختفاء، ولكنه يفسح لك من خلالها مكاناً رحباً في قلبه.
نظر بتهكم إلى رفاقنا المنهمكين ” بالتدريب العسكري” على لعب الورق (الشدّة أو الكنجفة كما نسميها بحلب) واقترب من حافة السرير وقال لي بصوت منخفض: “إذن .. أنت من جماعتنا”. مدّ يده لي وقال: “أنا خالد عبد الرزاق” صافحته قائلاً: “أنا جان مصري ووالدي يناديني حنا”. بنظرة ملؤها التواطؤ رفعنا الكتابين بيدينا عالياً كمن يتبادلان نخباً.
وهذا ما تعودنا على فعله طوال سنوات صداقتنا المديدة.
استعمل خالد اسمي في روايتين، وعندما سألته عن السبب. أجابني: “أحببته .. أي الاسم. وأحببتك”. لا تحتاج للكثير من الجهد كي تدخل إلى قلب خالد، شرطان وكفى: أن تكون حقيقياً ونزيهاً.
حققهما وادخل إلى عالمه الغني والواسع والأثير.
آمن خالد بأن “الحب هو السعادة الوحيدة القريبة من أصابعنا” لذلك أحب الناس وبادلوه الحب حتى ضاق قلبه عليه فأخذ يوسّعه بتلك الشبكات المعدنية التي لم تسعفه في النهاية. لكن ما فطر قلبه على الدوام أنه لم يحصل على حب حياته كما كان يسميه. أو على الأصح كان قد حصل عليه وخسره، فكان يؤنب نفسه باستمرار قائلاً: “أنا عاشق فاشل”. كتب في إحدى رواياته أن الحب يشبه باقة ورد طافية على وجه النهر، فإذا لم تلتقطها في اللحظة المناسبة ذهبت دون رجعة. حاولت مرة أن أهون عليه الأمر. فقلت له: في النهاية هي مجرد باقة ورد، بضع ساعات أو أيام وستذبل. نظر إليَّ باستنكار وقال: يا ويحنا إذا كان ما تقوله صحيحاً.
أحبّ خالد أيضاً حلب .. مدينته. ولكنها لم تبادله الحب. كافح فيها طويلاً كي يتمكن من العيش كما يريد لا كما يفرض عليه الآخرون دون جدوى. وعندما يئس من هذا النضال العبثي غادرها دون أسف إلى دمشق، حيث بنى هناك عالمه الخاص بعيداً عن سطوة التقاليد وقيود المجتمع. قال لي مرة:” قضيت فيها طفولتي وشبابي، ولكن أهلها لم يعتبرونني منهم، وكانوا يصفونني في كل مرة بـ (الضيعجي)”. وهو لفظ تحقيري يطلقه أهل المدينة على السكان القادمين من الأرياف يختصرون فيه أسوأ مظاهر التفاوت الطبقي والظلم الاجتماعي الكامن في المدينة. لم يُطقْ خالد الرياء المستشري في حلب، أي أن تكون في الظاهر مستقيماً وكريماً وورعاً، وترتكب في الخفاء ما تشاء من المعاصي. لذلك قسا خالد على حلب في روايته (لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة) وكشف بجرأة زيفها وتفككها. وبلغة تقترب من التشفي وصف ما فعلته سلطة (أبو فهد) المستبدّة بأهلها، إذ حولتهم إلى مجموعات من الوشاة والمتسلقين. يسيرون في الطريق منكسي الرؤوس كأرانب مذعورة، خائفين من بعضهم البعض، ومصابين بمرض الحنين إلى الماضي المجيد.
استعمل خالد اسمي في روايتين، وعندما سألته عن السبب. أجابني: “أحببته .. أي الاسم. وأحببتك”. لا تحتاج للكثير من الجهد كي تدخل إلى قلب خالد، شرطان وكفى: أن تكون حقيقياً ونزيهاً.
في ندوة جرت عبر الحواسب الالكترونية لمناقشة هذه الرواية بسبب استحالة الاجتماع في مكان ما بسورية أثناء الحرب. امتد النقاش لساعات طويلة وصبّ معظم القراء – الحلبيون خاصة – غضبهم عليه واتهموه بأنه قصد تشويه المدينة وتلويث سمعة أهلها. تأثر خالد بتلك الاتهامات واحتقن وجهه ولم يستطع أن يكون كعادته مرحاً وهادئاً. حاول مراراً أن يبرر موقفه، ولكنه في النهاية انتفض بكل غضب وقال: ” نعم حلب مدينة عظيمة وعريقة وجميلة، درة الشرق وقبلة الغرب. ولكن هذا مضى. وإذا كنتم عاجزين عن رؤية ما حلّ بها، فعلى أحد ما أن يقف في وجه الجميع ويقول الحقيقة. وأنا قمت بهذا الدور.
هل ندم خالد على قساوته؟ ربما. إذ سيسطر بعد سنوات رواية (لم يصلِّ عليهم أحد) فيعتبرها من أجمل ما كتب، ويبث فيها فيضاً من حبه وولعه بهذه المدينة. تحكي الرواية مسيرة حياة أربعة شبان يمثلون مكوناتها الرئيسية (أحمد وحنا ووليم وعارف) يكبرون معاً ويحلمون معاً. ولكن هذه المدينة المبنية من الحجر القاسي ستحطمهم دون رحمة.
لمست حب خالد لمدينته عندما زارها قبل عامين بعد انقطاعه عنها ثمانية سنوات. رافقته في جولة على أسواقها وخاناتها وأوابدها التاريخية. ورغم تحذيراتي المسبقة له إلا أنه لم يحتمل ما رآه من الخراب والدمار. جلس على أقرب حجر وتساءل: ما هذه الوحشية؟ ما هذا الحقد؟ ماذا فعلت هذه المدينة لهم كي يشوهوا جمالها بهذا الشكل. ثم انفجر بالبكاء.
في عشائنا الأخير بحلب ضحكنا كثيراً وبصوت عالٍ. فبدأ مَنْ حولنا بالتململ. فالضحك هنا غريب. والمثل الحلبي السائد أن الضحك بلا سبب قلة أدب. ونحن كنا نضحك بسبب وبلا سبب. كنا نحاول أن نتحدى أعداء الضحك، أولئك الذين زرعوا سنين عمرنا كلها بالخوف والأسى واليأس. كيف سنشرح لِمَنْ حولِنا أن قلوبنا متعلقة بهذه المدينة. وأن قلوبنا احترقت على ما حلَّ بها. وأننا جريحان نداوي قلوبنا بقليل من الضحك والنسيان.
قبل سنوات كتب خالد:
أيها الموت .. لماذا أخطأتني للمرة الألف.
ها أنا في مرماك أجرّ الشوارع وحيداً.
أية حياة تافهة تعاقبني بها.
في شوارع فارغة إلا من جثث أحبتي.
أيها الموت .. لم نعد نخافك.
نحن مّنْ يبحث عنك. وتفلت كزئبق من راحتنا.
ما الذي دفعك أيها الجميل لتتحدى الموت بهذا الشكل السافر؟ هل فقدت الأمل في عزلتك الطويلة فقررت الرحيل؟
أم أن (حنا) صنيعك الذي اكتشف أنّ لا أحداً ينجو من الطوفان قد ناداك إلى قاع النهر كي تستريحا معاً إلى جانب أحبابكما من هذا الشقاء. أم أن أصابعك ما زالت نادمة لأنها لم تستطع التقاط الباقة في اللحظة المناسبة.
نشرت على صفحة الكاتب على فايسبوك هنا وعلى النسخة المطبوعة من أخبار الأدب – البستان