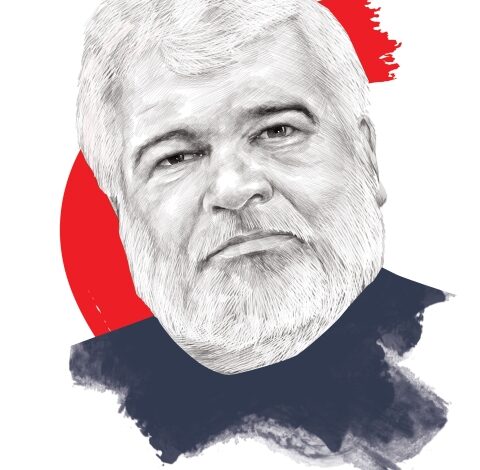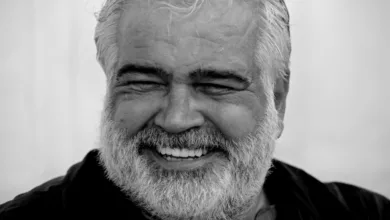في مقهى صغير على ضفة نهر ليمات في زيوريخ، التقيت الكاتب المصري الصديق وجدي الكومي، وحدّثني عن الحبسة الإبداعية التي يعاني منها منذ فترة ليست بالقصيرة. رأيت في عينيه قلق من يصابون من الكتّاب خصوصا ومن الفنانين عموما بتلك الحبسة. كان وجدي قد كتب على صفحته في “فيسبوك” يتحدث عن وضعه الصعب في فقدانه الكتابة، وفشل محاولاته في استدراجها لتعود إليه، أو يعود إليها، وطلب المساعدة من أصدقائه في تقديم المشورة والنصح.
أعرف هذا الشعور تماما، وأعراض هذا المرض الذي أودى بحياة كتّاب كانوا ذات يوم مشاريع كبيرة وطموحة، وأعترف هنا في هذه المناسبة بأن أكثر ما أخافه في الكتابة هذه الحالة، التي يتحوّل فيها الكائن إلى شخص أخرس، غير قادر على توصيف حالته، التي تبدأ باستهتار، ثم بقلق خفيف يزداد شدة مع الأيام، ثم بكذب على الذات، ثم بسكون يشبه همود جثة، فالموت والاستسلام لهذا الموت بعد فشل كل المحاولات لكسر هذه الحبسة أو تجاوزها.
لا تقتصر أعراض هذه الحبسة على كتّاب شباب كما هي الحال مع وجدي، وكما أصابتني ذات يوم حين كنت كاتبا شابا قبل ثلاثين سنة، بل تصيب كتّابا كبارا قضوا أعمارهم يعملون في الكتابة وفجأة توقفوا، كقطار يقطع البراري غير مبال، فخورا بقوته ومتانته، فجأة يصيبه عطل يحوله إلى خردة، إذا لم تأته النجدة خلال ساعات سيبدأ ركابه بالتململ أول الشيء، ثم بالشعور بضيق نفسي غريب لا يعرفون مصدره ولا علاجه، وفي النهاية سيتحولون إلى وحوش في محاولتهم لإنقاذ حياتهم.
يصعب تعداد الذين أصابتهم هذه الحبسة، لكن عشرات الكتّاب تعرضوا لهذه المشكلة بكل حالاتها وتجلياتها، ومنهم من توقف عن الكتابة بشكل كامل، والأسباب التي قيلت في حالاتهم لم تكن إلا تخمينات وتوقعات واجتهادات غير كافية لتشخيص هذه الحالة، نذكر في هذا المقام توقف ج. د. سالنجر (1919- 2010) صاحب “الحارس في حقل الشوفان” التي نُشرت عام 1951 وجلبت له شهرة ومجد أدبيين كبيرين، نشر بعدها ثلاثة أعمال قصصية وروائية، وتوقف عن النشر عام 1965، واختار حياة العزلة الكاملة التي دافع عنها بقوة.
يصعب تعداد الذين أصابتهم هذه الحبسة، لكن عشرات الكتّاب تعرضوا لهذه المشكلة بكل حالاتها وتجلياتها، ومنهم من توقف عن الكتابة بشكل كامل، والأسباب التي قيلت في حالاتهم لم تكن إلا تخمينات وتوقعات واجتهادات غير كافية
نتذكر في هذا المقام الكاتب الألماني الكبير غونتر غراس (1927-2015) الذي توقف عن الكتابة مرات عديدة، كان يعود فيها إلى الرسم والنحت اختصاصه الأول، لكنه كان يعود دوما برواية مهمة إلى أن قرّر بنفسه التوقف عن الكتابة، لنفاد الوقت بالنسبة إليه ولخيانات الجسد التي أصابته قبل رحيله.
لو أردنا تعداد حالات المبدعين الذين أصابتهم الحبسة الإبداعية الموقتة والدائمة لن نتوقف عن ذلك. لأنها حسب اعتقادي أصابت جميع من يتعامل مع الكتابة كمهنة، ولا نستطيع تعداد أسبابها، ولا طرق علاجها.
يعتبر العاملون في الطب النفسي هذه الحالة خللا نفسيا موقتا أو دائما يصيب المبدعين عموما، وليس الكتّاب فقط. وهم يوسعون دائرة الرؤية ويتحدثون عن حبسة الرسامين والمصورين والفنانين عموما. ويقدمون مساعدات للعلاج على طريقة مقاربتها مع أزمات نفسية أخرى تتعلق بضغوط العمل، يقدمون اقتراحات كالاسترخاء، والابتعاد عن مصادر الضوضاء، والسباحة والركض، والسير في الغابات، إلى ما لا نهاية له من وصفات عمومية تناسب جميع الأمراض.
هذه العلاجات حسب تقديري كمريض سابق، غير مجدية، لأن حالات التشخيص تخص كل كاتب بمفرده، وبالتالي علاجها يأتي من الكاتب نفسه، ومن الجانب الإبداعي وليس التقني. منهم من استطاع علاج نفسه وعاد أكثر قوة، لأنه استطاع تحويل الحبسة إلى فرصة وإجازة لتأمل منجزه، ومنهم من توقف إلى الأبد عن الكتابة، أو عاد بأعمال هزيلة لا تليق بسمعته وموهبته.
سأروي حكايتي مع ذلك المرض الرهيب الذي ما زلت أخاف منه حتى لحظة كتابة هذه السطور، لذا أتعامل مع الكتابة كاحتمال غير أبدي، يمكن أن تنتهي في أي وقت. وقتها “يتحول الكاتب الذي هجرته الكتابة إلى بئر مهجورة تشقق قاعها، وبدأت الأفاعي والديدان نهشها، تحولت إلى مصدر للروائح الكريهة لا بد من ردمها” كما كتبت في كتابي “نسر على الطاولة المجاورة” الذي صدر العام الفائت.
أذكر أنني في عام 1994 كنت أكتب روايتي “دفاتر القرباط”، وكنت وقتها بحاجة إلى إكمال العمل لأستطيع التأكد من أنني سأصبح روائيا، كانت ظروف حياتي سيئة جدا، أعيش في منزل العائلة في حلب، وأكتب في غرفتي من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا، فجأة في الفصل الثالث توقف كل شيء، كالقطار الذي تحدثت عنه في بداية المقال، كل ليلة أجلس إلى طاولتي ثماني ساعات دون أن أكتب حرفا واحدا. كان ذلك لقائي الأول مع الحبسة الإبداعية، في الأسبوع الأول بدأت أشعر بدوار حقيقي، وخوف، ودهمتني كوابيس رهيبة. نفذت كل وصايا المعلمين الذين كانوا ينصحون بالعمل اليومي وعدم ترك الطاولة، لكن دون جدوى، هاجمتني أفكار سوداء وعدت الى التفكير في الانتحار كحل وحيد لمعضلة حياتي. بعد تسعة وعشرين يوما طلبت المساعدة من المعلم الروائي عبد الرحمن منيف (1933-2004) الذي حلت منذ أسابيع قليلة ذكرى ميلاده التسعين، والذي احتفى بميلاده محرك البحث “غوغل”مثلما يليق بكاتب عظيم.
كانت تربطني به علاقة لطيفة، حدد لي موعدا في منزله في التاسعة صباحا، وحين وصلت من حلب إلى دمشق كنت مرهقا بعد سفر الليل المزعج والطويل. تحولت الساعة المخصصة لمشاركته القهوة الصباحية إلى حديث طويل استمر أكثر من خمس ساعات.
الكتّاب عموما يخفون هذه الأمراض، ويتبجحون بقدرتهم على الكتابة في أية لحظة، أو لا يقتنعون بأن توقفا بسيطا عن الكتابة ممكن أن يتحول إلى مرض عضال ينهي حياة الكاتب وإبداعه
شرحت له حالتي، كان واضحا على وجهي الألم الذي يعانيه عادة مرضى هذه الحالات، سألني ما رأيك بعلاج هذه الحالة؟ أجبته بأنه في الرواية التي أكتبها، بعد عشرين صفحة سيجري حدث كبير ورئيسي للشخصية الرئيسية أبو الهايم، ممكن أن يفتح مجرى السرد مرة أخرى. أردفت بأنني أخاف أن أعتاد الحلول الكسولة، وترك صفحات بيضاء عند حدوث أية مشكلة. لكنه ابتسم بطيبة أشعرتني بالثقة، وقال بأن من يجلس إلى الطاولة لمدة شهر دون كتابة ولا يغادرها رغم حبسته يربح الماراثون، وأضاف أن الحل الذي اقترحته مقبول إذا نجحنا في فتح قناة السرد، لأنه لا يوجد حل آخر لدى صديقك عبد الرحمن منيف مشيرا إلى نفسه، ولدى صديقيك ومعلميك وليم فوكنر وغبريال غارثيا ماركيز.
عدت إلى حلب بحماسة شديدة، وبعد ليلة فتحت قناة السرد المغلقة، تدفقت الكلمات وعاد إليَّ الأمل مرة أخرى. ما زلت حتى هذه اللحظة ممتنا لوجود الروائي والانسان الرائع والكريم عبد الرحمن منيف في حياتنا وحياة بلدنا.
حالة صديقي الكاتب المجتهد وجدي الكومي صاحب الرواية الجميلة “بعد 1897 صاحب المدينة” التي تعيد تفكيك حياة الرسام الإسكندراني العالمي محمود سعيد ومدينته الإسكندرية وزمنها، صرخة شجاعة على الملأ، لأن الكتاب عموما يخفون هذه الأمراض، ويتبجحون بقدرتهم على الكتابة في أية لحظة، أو لا يقتنعون بأن توقفا بسيطا عن الكتابة ممكن أن يتحول إلى مرض عضال ينهي حياة الكاتب وإبداعه، ويحوله إلى بئر مهجورة يجب ردمها كي يتوقف انبعاث الروائح الكريهة منها.
نشرت على المجلة هنا