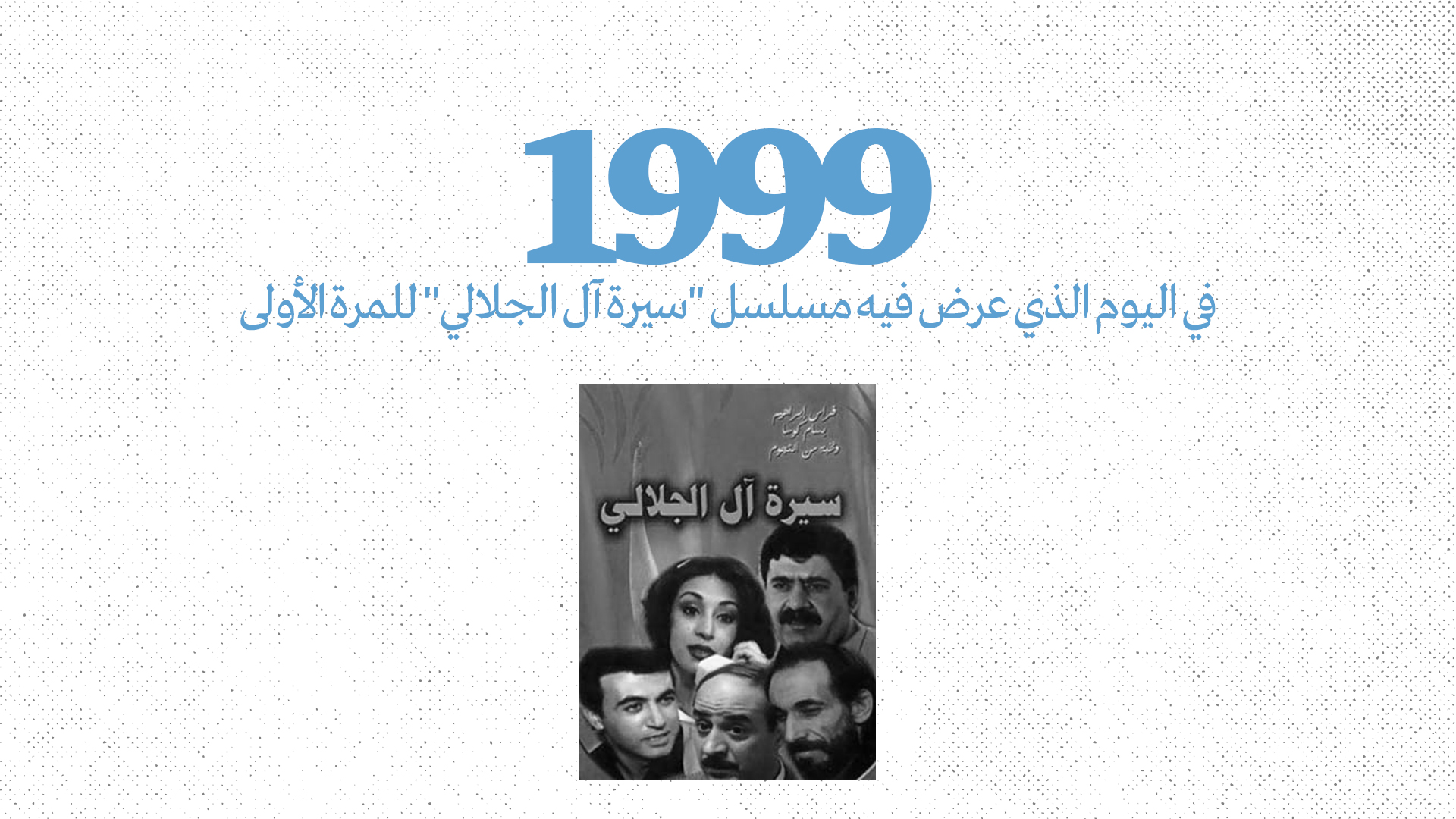في هذا الملف الصغير الذي أعددناه عن خالد خليفة، نحاوره في رواياته وفي خياره بالبقاء في سوريا ونسأله عن الرواية السوريّة، كما نرفق الحوار بصور خاصة اختارها خالد خليفة بنفسه لتعبر عن محطات شخصيّة في حياته، كما نُظهر خمس تواريخ مفصليّة في حياته اختارها هو، إضافة إلى شهادات مختلفة، إحداها من أحد أصدقاء خالد، وأخرى من شاعرة سورية وثالثة من ناقدة أدبيّة.
يبرز اسم خالد خليفة كواحد من أبرز الروائيين السوريين في العقد الأخير، ويكاد يكون أكثر الروائيين السوريين الذين تُرجموا إلى لغات أخرى ونالوا، أو ترشحوا لـ، جوائز عربية وعالميّة. صدر لخليفة حتى الآن ست روايات؛ “حارس الخديعة” كانت أولى رواياته وصدرت في العام 1993 ومن ثمّ “دفاتر القرباط” في العام 2000 من ثمّ “مديح الكراهيّة” في العام 2006 وتبعتها “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” في العام 2013 و”الموت عمل شاق” في العام 2016 وأخيرًا “لم يصل عليهم أحد” في العام 2019، إضافة إلى أربع مسلسلات تلفزيونيّة.
في كلّ روايات خالد خليفة يبرز المكان كأحد أبطال قصصه، حلب، مدينته الأم، دائمة الحضور في نصوصه، وكذلك ريفها القريب. في روايته الأخيرة “لم يصل عليهم أحد” يدور بقصته في أزقة حلب وفي قريّة حوش حنّا، وفي “مديح الكراهيّة” تكون حلب هي أساس القصة، وفي “دفاتر القرباط” يتنقل بين حلب وقرية العنابيّة وعفرين وخيام القرباط.
يقول خليفة في حواره معنا “إنّنا جميعًا صنيعة الأمكنة التي نعيش فيها” ولذلك يبني شخصياته بناء على المكان الذي تعيش فيه طفولتها، وربما يكون هذا سببًا إضافيًا يجعله يتعلق بالمكان الذي نشأ فيه، فيبني فيه قصصه وحكاياته.
لدى خالد الكثير ليقوله، لكنه يعمل ببطء وعلى مهل، يقول بأنّه يحب أن يعيش داخل الرواية، أو بالأحرى أن تعيش الرواية داخله، أن تُختبر وتُجرب وتتطور، ولذلك يُعتبر من المُقلين بالكتابة، فالفرق بين تاريخي صدور روايته الأولى وروايته السادسة ستة وعشرين سنة، وهو وقت طويل جدًا في عرف الكتابة والكتّاب، إن كان هناك عُرف لوقت الكتابة. رغم ذلك لم يفقد خالد خليفة جمهوره. لديه الكثير من القرّاء السوريين والسوريات، ومن الجنسيات الأخرى ومن الناطقين باللغات الأخرى، التي تُرجمت أعماله إليها.
لم يبخل عليّ خالد بأجوبته رغم المسافة الجغرافيّة التي تفصلنا، فاستمر حوارنا على مدى أيام، نراسل بعضنا عبر تطبيقات المراسلة المختلفة وعبر البريد الإلكتروني حتى وصل حوارنا إلى شكلّه الحالي، والذي آمل أن يشكّل قيمة مضافة إلى المهتمين بـ، والباحثين عن، شخصيّة خالد خليفة وأدبه، وكذلك لدارسي الأدب السوري، فضلًا عن أملي بأن يُمتع القارىء قبل أيّ غاية أخرى.
(خمسة تواريخ مفصليّة في حياة خالد خليفة اختارها بنفسه)
يقول إلياس خوري بما معناه أن الكاتب يستقي قصصه من الحياة فيعيد إنتاجها فيما يكتب، ليتلقفها القرّاء، فتؤثر فيهم الرواية ويعيدون إنتاج هذه الحكاية والشخصيات في الحياة. هذه مقدمة قصيرة لسؤال عن روايتك الأخير “لم يصل عليهم أحد”. ذكرت في آخر الكتاب بأنّك عملت على الرواية لمدة عشر سنوات، منذ بزغت الفكرة وحتى صدر الكتاب. كيف يحمل الكاتب/ كيف تحمل أنت/ حكايةً كلّ هذه السنوات؟ كيف تتعامل مع شخصياتها؟ أيؤثرون في حياتك اليوميّة؟ أهم جزء من أحاديتك اليوميّة مع أصدقائك؟ وما الذي تفعله بهذه الشخصيات بعد أن تصدر الرواية؟ يموتون أم يبقون معك، في حياة خالد؟
هذه طريقتي في العمل. دومًا يجب أن تعيش الرواية في داخلي قبل أن تُكتب. هذا حصل مثلًا مع “مديح الكراهية”، ومع الروايات الأخرى. الرواية الوحيدة التي لم تعش كثيرًا في داخلي هي “الموت عمل شاق”. لذلك في البداية يجب أن تعيش الفكرة ومن ثمّ عليها أن تثبت بأنّها جديرة بالكتابة، عليها أن تحاصرني، فأفكر بها لأوقات طويلة.
في العموم أكتب الكثير من المسودات. هذه المسودات تكون بمثابة اختبار للشخصيات، هل ستنمو؟ هل هي قابلة للحياة؟ وكذلك هذه المسودات هي اختبار للأفكار وللعوالم ولكلّ شيء. فيما بعد حين يُؤخذ القرار بكتابة الرواية فهذا لا يعني بأنّني أمتلك رواية.
قد أكتب عشرة آلاف كلمة أو خمسة عشر ألف كلمة وأتخلى عنها وأقول لنفسي إنّ هذا الشيء (هذه الرواية) لن تكتمل، أو أقول لقد أخطأت في هذا الخيار. لذلك فإنّ كلّ رواية تعيش في داخلي بجوار روايات أخرى لم تُكتب. يجب على الراوية أن تثبت بأنّها جديرة بالكتابة كي أكتبها.
أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال فأنا أتعامل بحياديّة، أو بشبه حياديّة، مع الشخصيات. دومًا هناك اختبارات. أصلًا تأتي الرواية عادة من أشياء غير متوقعة. مثلًا “لم يصل عليهم أحد” أتت من إحدى زياراتي إلى الجزيرة السوريّة، إلى القامشلي والمالكية وعامودا، حين رأيتُ تلك الكنائس المُهدّمة والمهجورة. روى لي شخص ما هناك قصة إحدى الكنائس، ففكرتُ حينها طويلًا بكيفيّة اختراعنا للقداسة وللقديس، والأمر نفسه موجود في الثقافة الإسلاميّة: كيف نخترع الولي؟
لدي قاعدة رئيسيّة: أنا أحبّ هذا المكان، وما زلت أحبّه رغم كلّ شيء، رغم أنّه، فعلًا مكان غير قابل للحياة، أو أنّ الحياة فيه أصبحت فعلًا شبه مستحيلة، أو صعبة جدًا.
خالد خليفة
حملت معي هذا السؤال منذ العام ٢٠٠٦، مذ قمتُ بتلك الرحلة، والتي كانت بهدف إنتاج برنامج وثائقي مع صديقي نديم آدو. منذ تلك اللحظة بدأتْ “لم يصل عليهم أحد” تحفر في داخلي. وبشكل رئيسي بدأ كلّ من “حنا” و”سعاد” و”زكريا” في الحفر بداخلي. لذلك تعاملتُ مع هذه الشخصيات الثلاث الرئيسيّة بعناية شديدة وفي كلّ مرحلة من المراحل كنت أنظر إليهم بشكل مختلف تمامًا.
شخصيات الروايات بشكل عام تصبح جزءًا من حياتي، لكنني أتعامل بطريقة “التقنية الباردة”، فلا أسمح لشخصيّة بأن تطغى وتأخذ حيز شخصيّة أخرى لأنّ هنالك شخصيات كثيرة بعد بداية الكتابة تتحلى بمكر شديد وبجاذبيّة خاصة، مثل “بلبل” في “الموت عمل شاق” أو مثلًا “حنا” في “لم يصل عليهم أحد” أو “رضوان” في “مديح الكراهية”. هذه الشخصيات تريد أن تهيمن على الرواية وعلى كلّ الشخصيات الأخرى، لذلك يجب ضبطها ويجب العمل معها بانضباط شديد وبقسوة، يجب أن لا تأخذ فضاء وحيز الشخصيات الأخرى إلى ما تحتاجه. هذا شيء أساسي.
تكون الشخصيات جزءًا من أحاديثي اليوميّة. فأنا حين أكتب رواية يعرف كلّ أصدقائي المقربين ذلك. اختبر نفسي والراوية بأصدقائي. أحيانًا أطلب منهم قراءة فصل أو خمسين صفحة ومن ثم أحقّق معهم. دومًا أصدقائي كرماء جدًا معي. يقدمون لي هذه الخدمات بكلّ قلب طيب ومفتوح. لذلك لا توجد لدي رواية طُبعت فورًا. تبقى في الحد الأدنى سنتين بعد الكتابة خاضعة لاختبارات وكتابات مختلفة؛ كتابة أولى وثانية وثالثة… في “لم يصل عليهم أحد” وصل العدد إلى تسعة عشرة كتابة. هناك من أصدقائي من بدأ بالقراءة منذ الكتابة الثالثة أو حتى منذ الكتابة الأولى. وأقصد بالكتابة المسودة الكاملة، أي أنّ الرواية منتهية تقريبًا. هذا عمل مضنٍ جدًا، لكنه ممتع جدًا بالنسبة إلي. والمحيطين بي يعرفون ذلك جيدًا، وفي أغلب الأحيان أشكرهم بشكل شخصي في نهاية كل رواية.
لكن بعد صدور الرواية تموت بالنسبة لي. لا توجد لي معها أي علاقة بعد صدورها. بعد أشهر من صدروها تنتهي الرواية. لكن أحيانًا بعض الشخصيات تبقى. مثلًا “حنا” و”سعاد” حتى الآن، حتى هذه اللحظة، بعد سنتين من طباعة الرواية، ما زالا يزوران كوابيسي وأحلامي، وأفكر بهما كثيرًا وهذا يحدث لأول مرة لي.
أفكر أحيانًا بـ “بلبل” لكن كما يفكر المرء مع شخص عاش معه لفترة زمنيّة ثم مات، وينظر إليه من بعيد وكأنّه يستعيد ذكريات قديمة. لكن مع “حنا” و”سعاد” فالأمر مختلف تمامًا. ما زالا يعيشان معي حتى هذه اللحظة. ويجب أن يخرجا بأقرب وقت ممكن وإلّا سيكون وجودهما مشكلة حقيقة بالنسبة لي.
في روايتك الأخيرة مثل رواياتك الأخرى، تُغرق القارئ بتفاصيل الأمكنة. أحيانًا أشعر بأنّ المكان هو بطل الرواية لا الشخصيات. لماذا هذا الهوس بالمكان؟
أعتقد أنّنا جميعًا صنيعة الأمكنة التي نعيش فيها، والتي نولد فيها بالتحديد، لذلك لا توجد شخصيّة خارج المكان الذي تولد وتنمو فيه. قد تموت في مكان آخر، لكن الطفولة هي المنبع الأساسي للكتابة. بالنسبة لي دومًا أسأل شخصياتي أين قضت طفولتها وما هي الأمكنة التي عاشت فيها. لأنّني ببساطة (أحكي عن نفسي هنا) صنيعة تلك الصور الغامضة وتلك الأمكنة التي مازلت أحتفظ بها (حتى بروائحها) حتى الآن، لذلك العلاقة مع المكان ليست هوسًا كمان تقول، بل هي إعادة تمركز وإعادة تفكيك الشخصيّة بشكل رئيسي.
(خمس صور شخصيّة تعني الكثير لخالد خليفة، وقد أختار الصور بنفسه، وهي تُنشر في حكاية ما انحكت بموافقة شخصيّة منه)
السؤال السابق كان ما يشبه التحضير لهذا السؤال. تعيش في دمشق رغم قدرتك على العيش في أيّ مكان تريد. تصرّ على البقاء في سوريا، رغم أنّها تكاد تكون غير قابلة للحياة. لماذا هذا الإصرار؟ هل تخاف من الخروج من هذه البلاد؟ أتتحدى شيئًا ما ببقائك هناك؟ ومن ثمّ، ما الذي تعطيك إياه سوريا ولا تستيطع الحصول عليه خارجها؟
ليس لدي جواب واضح. لدي قاعدة رئيسيّة: أنا أحبّ هذا المكان، وما زلت أحبّه رغم كلّ شيء، رغم أنّه، فعلًا مكان غير قابل للحياة، أو أنّ الحياة فيه أصبحت فعلًا شبه مستحيلة، أو صعبة جدًا. هنالك مصاعب لا يمكن تخيلها. لكن بالنسبة لي ما زال هذا المكان هو المُفضل بالنسبة لدي والقاعدة تقول: إنّ أيّ أحد في هذه الظروف الصعبة جدًا يستطيع أن يتمسك بمكانه يجب أن يفعل ذلك. إذا هاجرنا جميعًا، من سيحرس المنازل المهجورة؟ من سيحرس الأرواح؟ ومن سيحرس المقابر؟
أنا لستُ حارسَ المقابر لكنني حارسُ الأرواح، وما زلت أعتقد بأنّ هذا هو المكان الوحيد الذي يعنيني في كلّ شيء. حتى اليوم، كلّ شيء في سوريا يعنيني. أعتقد، في ألمانيا مثلًا هناك أشياء كثيرة لا تعنيني، لأنّني ببساطة لا أعرف الأشياء هناك، لا أعرف كيف بُنيت ولا أعرف كيف تشكلت. ما زال حلمي ينمو هنا كلّ يوم. ما تعطيني إياه سوريا هو هذا الإصرار بالبقاء فيها. هذا الإصرار هو جزء أساسي من حياتي، وهذا ليس وليد اليوم، ليس وليد ما بعد الثورة. أنا أنتمي لجيل مُهاجر، منذ الثمانينات هاجر قسم كبير من أبناء جيلي وكانت مواهبهم واضحة وبارزة وكبيرة، لكن وببساطة شديدة بعد سنوات انتهت مواهبهم. أنا أخاف أيضًا أن أفقد هذا الحبل السري بيني وبين الكتابة.
سوريا تعطيني، حتى الآن، كلّ شيء. الألم والأمل والذاكرة. حين ترتب ذاكرتك تسطيع أن تقول بأنّك ترتب مستقبلك وحلمك. السؤال يجب أن يكون: ماذا يعطيني الخارج؟ أعتقد بأنّني أستطيع أخذ كلّ ما أريد من الخارج وأنا هنا، لذلك لا أجد أي ضرورة لوجودي هناك.
أعرف أن وجودي في أوروبا قد يساهم في زيادة انتشار كتبي بنسبة عشرة بالمئة أو عشرين بالمئة أو ثلاثين بالمئة… صدقًا، أنا لستُ بحاجة لها.
تترجم رواياتك إلى العديد من اللغات، وتنال الجوائز هنا وهناك. ما الذي يغير هذا في طريقة كتابتك وفي شخصيتك؟ أتعنيك الجوائز والترجمات والقرّاء غير الناطقين بالعربيّة؟
الجوائز والترجمات والشهرة وكل ما إلى ذلك هي تمامًا خارج الكتابة، ويجب أن ننتبه لذلك. كلّ شهرة زائدة تشبه فائض القوة، ويجب تصريفها. وغالبًا ما يُصرف هذا الفائض بشكل سيء جدًا. لذلك يجب أن ننتبه إلى أنّ هذه الأشياء لا تعني الكتابة.
أنا شخص أحبُّ الجوائز وأحبُّ أن أرى كتبي مترجمة إلى كلّ لغات العالم وأحب أن أجادل القرّاء من لغات أخرى وتصلني أحيانًا آراء تسعدني جدًا لكن هذه أشياء أدعها على الباب في الخارج حين أعود إلى الكتابة. يجب أن لا يصطحب الكاتب هذه الأشياء معه إلى مشغل الكتابة.
سوريا تعطيني، حتى الآن، كلّ شيء. الألم والأمل والذاكرة. حين ترتب ذاكرتك تسطيع أن تقول بأنّك ترتب مستقبلك وحلمك.
خالد خليفة
مشغل الكتابة هو مكان مختلف تمامًا. يجب أن يحافظ المكان على بروده. ويجب على الكاتب أن يدرب نفسه على تلقي الثناءات دون أن تعبر هذه الثناءات الباب. يجب وضعها خارج باب مشغل الكتابة.
إجمالًا، شهرة الكاتب تختلف عن شهرة العاملين في مجال الفنون الأخرى. في مهنة التمثيل مثلًا، كلّها قائمة على الظهور وعلى الشهرة وعلى التماس المباشر مع المشاهدين لكن الكتابة قد تنمو في أكثر الأماكن المظلمة. أعتقد بأنّ هذا أمرٌ حسن. العزلة جزء أساسي من الكتابة، حتى لو كنت موجودًا بين آلاف البشر. الكاتب شخص وحيد ومعزول دومًا.
سؤالي الأخير هو سؤال عام عن الرواية السوريّة ويتكوّن من شقيّن. الشق الأول: ما هي الراوية السوريّة؟ وكيف يمكننا التعريف عن الرواية السورية؟ هل هي موجودة على خريطة العالم الأدبيّة؟ وما الذي يميزها؟ الشق الثاني: ما هي العلاقة بين الرواية وما يحدث في سوريا منذ آذار ٢٠١١، من ثورة وحرب أهلية واحتلالات؟ كيف أثّرت الأحداث على لغة الرواية السوريّة وبنيتها وأفكارها وشخصياتها وأحداثها؟
الرواية السوريّة هي الرواية التي يكتبها السوريون. لكن إن تحدثنا عن خصوصيّة معينة عن الرواية السوريّة فأنا أعتقد بأنّها مرت بكلّ المراحل التي مرت بها الرواية العربيّة وحملت كلّ أمراض الرواية العربيّة، فهي جزء من الرواية العربيّة. ولا تختلف كثيرًا، سواء بالتقنيات أو بغيرها من الأمور، عن الرواية العربيّة. لذلك نستطيع أن نقول إنّ هنالك رواية عربيّة تكتب في سوريا باللغة العربيّة.
وإذا تحدثنا عن وجودها في العالم، فوجودها قليل جدًا وهي تعتبر جزءًا من الرواية العربيّة وأعتقد بأنّ الرواية المصريّة هي المتفوقة في كلّ المجالات، باستثناء الروايات الجزائريّة والمغربيّة المكتوبة باللغة الفرنسيّة ولكن هذا بحث آخر. لذلك نستطيع أن نخلص الأمر بأنّ الرواية السوريّة هي جزء من الرواية العربيّة، وخصائصها هي خصائص المكان الذي تكتب عنه.
حسنًا، هنا يحضرني سؤال متفرع من السؤال الأصل: وما وضع الرواية الكرديّة السوريّة المكتوبة باللغة العربيّة، كيف تصنفها؟
أعتقد أنّ كلّ الروايات المكتوبة باللغة العربيّة يمكن تصنيفها كرواية عربيّة، أو يمكن القول رواية كرديّة مكتوبة بالعربيّة. أنا أعتقد إنّ هذه التصنيفات غير مهمة. في النهاية فإنّ اللغة هي العنصر الأساسي. الروايات المكتوبة بالعربيّة هي روايات عربيّة. خصائص كل بلد مختلفة. مثلًا خصوصيّة سليم بركات واضحة كمنطق وككاتب وكبيئة، وهو يختلف كثيرًا عن كاتب ما في الجزائر، لكن في النهاية نحن نتحدث عن اختلافات موجودة تحت مظلة واحدة وهي مظلة الرواية العربيّة. لأنّ اللغة هي الأساس. كما أنّني بشكل عام غير مكترث، وأعتقد بأنّ هذه التصنيفات لم تعد مهمة.
أما بالعودة إلى الشق الثاني من سؤالك فإنّ الشيء الذي يمثل الرواية السورية بعد ٢٠١١ هو الانفجار، انفجار الكتابة. هناك أعداد ضخمة من الكُتّاب. لكن أعتقد أنّه حتى الآن لا يوجد شيء هام من حيث التطورات التقنية أي لا نستطيع أن نقول بعد إنّ هنالك تطورات تقنية في لغة الرواية السوريّة أو أيّ شيء جديد آخر. هناك محاولات، لكنها ما زالت خجولة. وهذه المحاولات أيضًا تخضع للتاريخ. أي يجب أن ننتظر ونرى كيف سيصبح شكل الكتابة في سوريا فيما بعد.
شهادات في خالد خليفه ورواياته

كان ذلك في سبعينات القرن الماضي. كنت في سنتي الرابعة في كلية طبّ حلب عندما أصابتني جائحة كانت سائدة وقتها في سوريا، وكانت تفضّل طلبة الجامعة. ذلك الفيروس كان اسمه: البحث عن البديل الثوري. من تقاليد هذا النوع من الجائحات أنّ المصاب لا يتجنّب الناس، بل يسعى إليهم، وخاصّة أولئك الذين يشاركونه العدوى. وفي بحثي ذاك عثرت على شلّة كاملة عبر زميل الدراسة أحمد خليفة، وهو الأخ الأكبر لخالد.
كانت تلك الشلّة تعرف جيّداً ما لا تريد، وهو كل ما كان موجوداً في الساحة السياسيّة في السبعينيّات، سواء في السلطة أو خارجها. لكنّها لم تكن تعرف ما تريد. ربّما لم يكن من الظلم أن نصفها بأنّها خليط من فوضويّي القرن التاسع عشر وشيوعيّي القرن العشرين بتلاوينهم المختلفة، بما فيها من “مزج للألوان”، كالفرويدية والوجوديّة مثلاً. ولذلك فقد كانت تثقّف نفسها بكلّ ما كان أولئك وهؤلاء يستظرفونه من فكر وأدب وفن وتحضّر نفسها لقيام كومونة باريس في حلب.
كان خالد المراهق واحدًا من الشلّة رغمًا عنه. كنّا نراه “يكبر فينا” دون أن ندرك حقيقة أنّنا نحن من سيكبر فيه. فنحن في الواقع لم نكن سوى أعمام يحبّون الكلام الذي يستطيعون قياده. أمّا هو فكان يكره كلّ كلام سهل القياد. وكنّا نحلم، دون أن ندري، بأنّه يستطيع ما عجزنا عنه. ولذلك فلم يكن أحدنا سعيدًا بعمله الروائي “دفاتر القرباط”. وهي “سعادة” بدأت بالنموّ كلما تميّز ذلك الفتى الذي قفز برشاقة من وادي الشعراء الضبابيّ إلى قارّة الروائيين الكونيّة.
أعدت التعرّف على خالد الجديد في برلين. أسجّل لنفسي أنّني استطعت النجاة من مصيدة الأعمام الذين يقابلون “أبناء إخوتهم” بعد عمر طويل. ربّما كان السبب هو أنّ خالد استطاع تجاوز تلك المصيدة، بنفسه. كان هذا الفتى الأزلي لا زال يبحث عن كلام جديد صعب القياد. فكّرنا معاً بصوت عالٍ. كانت إحدى أفكاره تلك أن يكتب عنّا، شلّة الأعمام القديمة. وكانت إحدى أفكاره الأكثر جدوى هي الكتابة عن حلب. وقد فعل وأرسل لي النص بعد زمن لأقرأه وأبدي ملاحظاتي. وكانت “لم يصلّ عليهم أحد”. اكتشفت في قراءتها الثالثة الذات الأعمق في خالد، الذات المتمرّدة. إنّه خالد المتمرّد في تاريخ يفضّل النوم.

بمناسبة صدور الطبعة الثالثة من رواية (حارس الخديعة) للكاتب خالد خليفة، في أيلول الفائت، تذكرت قراءتي الأولى لها منذ بضع سنوات، كانت الرواية\النص تختلف عن الروايات الأخرى. ومهما كان تجنيس هذا العمل بأنّه نص مفتوح أو رواية، لكن يبقى له ملامح خاصة يمكن استكشافها وخاصة في طريقة التعامل مع الزمن.
إنّ رواية\نص (حارس الخديعة) لا تحتوي على قصة محوريّة أو على تصاعد متدرج للحدث، مما جعلها أشبه ما تكون بسرد مفكك لأحلام غير مترابطة. لكن القضيّة الأساسيّة التي لا تنفك تتكرر فيها هي قضية الزمن المعطل، لأنّ اختفاء التتابع الزمني يتجلى على صعيد المضمون، وفي الوقت نفسه في طريقة صياغة النص؛ أي أنّ هذه الرواية\النص لا تكتفي بترديد جملة “الوقت أكذوبة والساعات معطلة” فحسب، بل هي تجسّد ذلك عن طريق التداعي والتكرار وعدم التصاعد في وتيرة السرد، أي أنّها استمرارية شعوريّة متدفقة يتحكم فيها وعي الكاتب بحالته الداخلية التي لا يمكن قياسها بالزمن العادي.
إنّ الصياغة الشعريّة للنص هي أقرب إلى تداعيات شظايا أفكار وذكريات يتكرر سردها أكثر من مرة، وبالتالي لا يوجد أي تطور ملموس في الأحداث المنقولة بصيغة المضارع وكأنّها ما زالت تستمر بالحدوث، بالإضافة إلى أنّها لا تتراكم لتصبح في الزمن الماضي، عدا بعض ما يتم تذكره عن طريق التداعي، فيُنقَلُ بالزمن الماضي. وفي النهاية رغم اختلافنا على تجنيس هذا العمل الأدبي، فهو يستحق تقصي خصوصيته، وإضاءة مكامن الاختلاف فيه.

عرفتُ خالد خليفة من خلال أصوات أصدقائه القدامى أولًا. تشكّلت صورته في ذهني من خلال كلماتهم عنه. في عام 2013، في مقهى في مدينة حلب أعطاني صديق مشترك بيني وبينه نسخة من روايته “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”. أتذكر أنّني أعرتُها بعد قراءتها لصديقتين أيضًا. تولّد لدينا جميعًا ذلك الخوف من رؤية أحد ما الرواية بين أيدينا في بيئة كانت مؤيدة في غالبيتها. فجأة، أصبحت الرواية بمثابة فخ منصوب لنا!
هذا ما تأكدتُ منه نهاية عام 2013 حين أخذتُ معي الرواية إلى كوباني. في تلك الرحلة، وقفت الحافلة على حواجز عسكريّة مختلفة، حواجز للنظام وأخرى للإسلاميين وثالثة للجيش الحر. الروايّة كانت بين مجموعة كتب أخرى مخفيّة بين الثياب في الحقيبة. كنت أشعر بخطرها في تلك الأجواء المشحونة بالتعصّب والتسلّح والاستبداد.
في برلين التقيتُ لأول مرة بخالد خليفة. كان فوضويًا بشكله، مع ابتسامة مملوءة بالرِقة، مع ذلك الدفء الإنساني الذي يرافق كلامه. تحدثنا كثيرًا منتظرين صديقًا قديمًا من أصدقائه. أزاح بروحه المرحة المعتادة فخاخ اللقاءات الأولى. ونحن نسير على ضفاف “نهر شبري”، كنت أجري بداخلي مقارنات لابد منها، بين خالد الروائي المعروف بشكل كبير وبين كتّاب أخرين لم يحصلوا على ربع شهرته، كانت المقارنة لصالحه دومًا، فخالد كان ميّالًا للهوامش أكثر من المركز، وداعمًا للكتّاب الشباب كما سمعت من عدّة أصدقاء وصديقات.
برفقته تشعر أنه صديق قديم وحميمي. طبخ لنا في ذلك اليوم مجدرة البرغل مع العدس في بيت صديقنا المشترك، وتحدّث مطولاً عن بيت العائلة القديم ونسائه في حلب، عن تلك المرحلة من تاريخه وحياته. كان شغوفًا وهو يتحدث عن الماضي أكثر من الحاضر. وكنت ألاحظ هذا حين يتحدث عن تاريخ حلب أيضًا، فينسى الزمن الحاضر، لتشعر أنه حكّاء يجول بك في أروقة أزمنة قديمة. كنت تستطيع أن تشم روائح ذلك الزمن في حديثه.
نشرت على موقع حكاية ما انحكت هنا