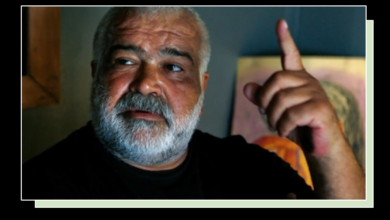كم هو مثير للسخرية أن يُكتبَ عنك نص تأبين، كم هو غير لائق.
ربما أثارَ هذا الكمُّ الهائل من المحبة لك الاستغراب، ولكن كلَّ ما في الأمر هو أنك لم تحتكم يوماً إلّا لقيم وحكم بسيطة، بدهية للغاية، إنما بحزم؛ جمال الواضح الذي أتقنته كما لم يفعل أحد. لذلك، وجب أن نحيي ذكرك أيضاً بما هو جميلٌ على نحو واضح، كالوشم على باطن اليد، بكلمات صادقة وبتلات ورد منثورة في الأرجاء، أو سهرة سَمَر واعترافات لمن نحبهم.
قَدَرُ الوداعات أن تكون باردة ومُتوقَّعة إلى أبعد الحدود، جزءاً من يوميات اعتيادية وقابلة للتكرار في أي وقت، كجزء من ذلك الجميل الواضح، والأليف. أكثر مناسبة كليشيه في برلين، تلك التي لمحتكَ فيها آخر مرة: حفلة تكنو. الرؤية ضبابية، إما من فرط التدخين أو مؤثرات الدخان، لمحتكَ مُستنِداً على الحائط تتفرّجُ على الحفل من الخارج، شققتُ الضباب باتجاهك، باتجاه عيون تلمع بحدّة في العتمة. دون كثير من الكلام لفرط الضجيج، تحادثنا. أشرتَ لي تسألني ماذا أشرب. أريتكَ قنينة ماء، قلتُ لكَ إنني أكتفي بشرب الماء فقط لضبط وزني. هززتَ رأسك بازدراء للفكرة. كانت لك عليَّ سلطةُ السخرية، مُسلِّمةً لك بها منذ زمن طويل منذ بداية معرفتي بك، ستة أو سبعة عشر عاماً؟ كان ضدَّ عقلك أي شيء من هذا القبيل، أي ممارسة أسر لمزاج الإنسان، الدايت والرقابة على الذات وزجرها، والقلق بشأن صورة المرء أمام الناس.
هذه كانت من ضمن الحِكَم البدهية التي شكَّلَتْ صورة حياتك. كنتَ تسأم وتشيح بوجهك دون اهتمام عن أي محاولة حصار، وإن كانت بلبوس المحبة. حرصتَ في تعاملكَ معي وأنا شابة في بداية العشرينات أن تدفعني لأكون رحيمة مع نفسي وحسب، دون اعتذار، في مواجهة العالم وفي مواجهة أي محاولة لإحراجٍ وتَصيُّد، مُستذكِراً من تجاربكَ كيف تعرضت لعتابٍ حول قصة من ماضيك وقلت لصاحبة المعاتبة: «اسمعي، قد تسمعين عني قصصاً شديدة الروعة وأخرى شديدة الإحراج، وغالباً كلها قصص صحيحة، شأنك هو ما ترينه مني».
الكتابة، على كل حال، لم تكن من بين أمور تأخذها باستهتار كما محاولات التَصيُّد تلك. كان من المعتاد أن يراك الناس مُنكبَّاً على الكتابة لساعات في المقاهي، وأن تنشغل بالاطلاع على إنتاج الكل من حولك، من كُتَّابِ أولِ نصوصهم إلى الأكثر رسوخاً في مسارهم، مُتحمِّساً لإبداء رأيك وتشجيعهم، وتوبيخهم على التكاسل أيضاً، في علاقةٍ لم تحمل يوماً أي توجّس واستئذان. تُرسل مسجات فجائية، إيجاباً وسلباً، وكان من المعتاد أن يكون المرء جالساً بأمان الله، ويأتيه مسجٌ حاسمٌ من خالد خليفة: «قريتلَّك شي اليوم ما حبيته».
كان هذا السلوك جزءاً مما عِشتَه؛ كرهتَ أي سلوك انكفاء وجبن وكان هذا فعلاً مرذولاً حتى في كتاباتك، بما يشمل تواجدك في حياتنا كأمر واقع، إذ لم تكن يوماً تنتظر من يفتح لك الباب في علاقتك بالآخرين وفي حضورك في حياتهم والمبادرة تجاههم. وكان من المعتاد أن «يَربَى» أبناء جيلي، ممن اتجهوا للكتابة والفنون في مطلع شبابهم، في المقاهي والبارات وهُم ينادوك خالو كأمرٍ واقع؛ من المؤسف أنكَ على الغالب لم تعي يوماً كم نَفَعَنا أن نحظى بهذه النسخة من المربي غير الفاضل، بديل الخال الذي كان ليساعدك في الهرب من حصص الدراسة ورقابة الأهل ويُغطّي عليكَ لتخرجَ في موعد غرامي ممنوع، الذي يسعى ليغرس فينا قيماً وسلوكيات حياة مفيدة حصراً في انفلاتنا من قيود أي سلطة وتَردُّد، وفي انفكاكنا من إرث طويل وعميق من انضباط مؤسسات العائلة والدراسة، وفي إدارة قصص حبنا ومغامراتنا إلى حدِّها الأقصى.
كل طلعة معك كانت احتمالات مفتوحة، تعارف مع أشخاص لا نعرفهم على طاولات مجاورة، طلعة سريعة تتحول إلى مجزرة لهو في أماكن متفرقة من المدينة حتى الصباح، ثم اضطرارنا لتنظيم حفلات مبيت ارتجالية في منزلك بعد تَعذُّر العودة إلى منازلنا لتأخر الوقت وصعوبة التنقل بين الحواجز المتنوعة، لننتهي في حفلة المبيت هذه مع جمع عشوائي من معارف وآخرين تَعرَّفنا عليهم للتو، أو صحفيين أجانب رمتهم الأقدار في هذه الزحمة، وكانوا قد التقوا بك بهدف تسجيل شهادة سريعة في قلب النهار فقط في البداية. في أحد أيامي الأخيرة في دمشق، عام 2012، حين كانت الحواجز تقطع أوصال المدينة، كنتُ خارج بار القصبجي بعد انتهاء السهرة في أول ساعات الفجر أنتظرُ تاكسي، مررتَ بسيارتك الصغيرة بالصدفة أمامي، توقفّتَ وأخذتني معك لتوصلني إلى المنزل. حينها كنتُ خائفة من الحواجز لأنني لم أحمل هويتي، وكانت ذراعك مُضمَّدة إثر كسرها يوم اعتقالك من تشييع مقبرة الدحداح. أمام أول حاجز طالبني بالهوية، وقبل أن أُصدِّرَ له ارتباكي وأُخرِّبَ الموقف، مِلتَ على المقود وصحتَ باستنكار عبرَ شُبّاكي: «معقول ما عرفت مين هي!! هي الكاتبة الشهيرة رشا عباس».
ليهز العسكري رأسه ببعض الارتياب، ويدّعي أنه «سمع بالاسم». تكرّرت محادثات كهذه على حواجز الطريق، حتى وصلتُ إلى المنزل بأمان.
«وصلتُ متأخراً عن المجزرة بسبب اللهو»
ملاحظة عشوائية وَقَعتُ عليها وأنا أُقلِّبُ في ملاحظات واقتباسات كنتُ قد دونتها جانباً منذ فترة قريبة، وأنا أقرأ رواية لم يصلِّ عليهم أحد. في مكانِ أخر ملاحظة: «شخصيات مغامرة – تفتح ذراعيها للحياة، تفضيلات الكاتب واضحة – تتسرب إلى وصف الشخصيات. احتفاء الكاتب بالمغامرين من الصفحات الأولى، ثم سرعان ما تتكثف الفكرة أكثر مع الحديث عن غرفة مخصصة للمنتحرين في القلعة». كما كثير من الأحاديث والاستحقاقات المُؤجَّلة، لم أنشر منها شيئاً ولم نتحدَّثْ بشأنها.
دروس لا تنتهي، من جملة حِكَم الحياة البدهية البسيطة. من خلالك عرفتُ كيف يُدير المرء حتى أحسن صيغ الخصام كما صيغ المودة، كيف يمكن للناس أن تتفرق طرقاتهم، وتتجافى حتى، دون أن يكونوا أنذالاً بالضرروة. أن يكون المعيار الأول عندما نلتقي، سواء كنا قد اختلفنا أو كنا قد انقطعنا دون سبب عن التواصل لسنوات، هو الودّ و«الأصول»، الطيّبة منها لا القمعية التي كنتَ تأنفُ منها.
كانت الحياة قد جعلتك أكثر هدوءاً وتسليماً، بعد سنواتٍ من الخراب، كبرتَ وكبرنا. في زيارة قصيرة إلى أميركا عام 2016 كانت أطول فترة قضيتها معك خلال الأعوام الأخيرة. كنتَ في إقامة أدبية في بوسطن، حيث زرتكَ وفتحت لي منزلك هناك. وصلتُ متأخرة لأجد طنجرة كوسا محشي عملاقة بانتظاري، رغم أنك كنت متعباً وعلى وشك أن تغفو حين وصولي. تحدَّثنا لدقائق فقط، أخبرتني أنك تملُّ العيشة لوقت طويل خارج دمشق، التي حاولتَ إحياءها في أي مكان حللتَ به. ذهبت لتنام، وفي الأيام التالية تصرَّفت كأي خال كُلِّفَ فجأة برعاية وَلدٍ من العائلة، حريصاً ألّا أملَّ في غيابك وانشغالك، فكنت تتصل مع أصدقائنا في بوسطن، طه ومحمد، لتتأكد أنهم يفسحون مكاناً لي في مشاريعهم وفسحاتهم اليومية، كمن يحاول أن يجد لي ناساً من عمري لألعب معهم. حدث بعد ذلك أن قطعتَ الإقامة فعلاً وعدتَ إلى دمشق، التي لم يكن ليُغنيكَ عنها في الغربة ضيفٌ من هنا ومواعيد مبعثرة من هناك. عدتَ إلى حيث أسَّستَ منزلاً من جهد سنواتٍ طوال، إلى حيث احتمالات لقاءات عشوائية في الطرقات، وجمعات على مائدة تُعِدُّها بكثير من المحبة والفلفل الحار القاهر لألسنة الضيوف، حتى أنك كنت تنوي تأليف كتاب عن الطبخ، وكنت مصراً على أن المحبة أهم من الإتقان فيه.
عدتَ إلى دمشق لتحيا وفياً لكل ما آمنتَ به وكتبتَ يوماً عنه؛ الانتصار بدون مواربة لقيم الانعتاق والشهامة والمحبة، بيدٍ ممدودة للجميع، بما يشمل حبك، على طريقتك، للبلاد وأهلها دون شرط يقيدك ويحاصرك بدوره، عدتَ لتبقى مع من بقيوا ومن جاءوا بعدنا، قاسمتهم خبزك ومحبتك ونُبلك وفرحك، كما قاسمتَنا فرحك الذي كنت تنوء بحمله إن كنت وحدك. حتى في رحيلك المفجع، جميلاً، جميلنا، المُسجَّى على بتلات الورد والضحكات وأغاني الطرب وسِيَر العاشقين وذوي المروءة، تركتَ لنا ما نتقاسمه من أثر ذكراك الطيبة إن لم يكن هناك من أبدية نلقاكَ فيها بعد حين.
نشرت على الجمهورية هنا