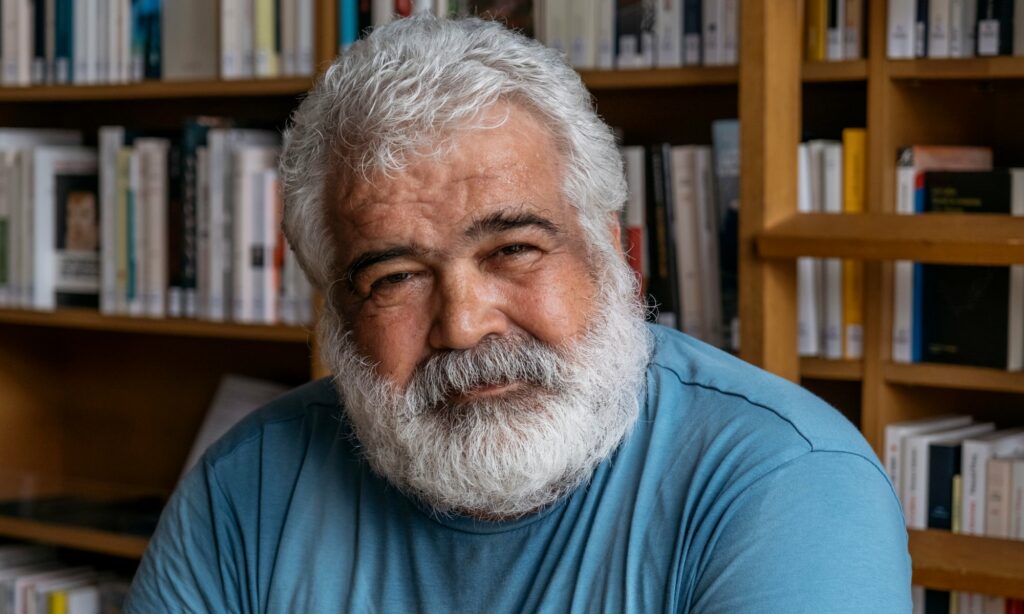
كاتب الحب والموت
سميرة المسالمة
في كل مرة يعود فيها إلى دمشق، كنت ألملم أطراف طلبي في بقائه آمنًا بعيدًا عن صخب الحرب، وروائح الموت، ولكن لمعرفتي به جيدًا، كنت أهذب سؤالي بقولي لمَ العجلة؟ يجيب بضحكته المعهودة: لأنتظركم عندما تعودون. نعم، هو يحمل ذلك القدر من الأمل في أن دمشق ستعود لتضج بسهرات أصدقائه في كل مكان، على الرغم من أنه من لم ينكر في أي مرة أي سوء ينال من السوريين.
كان الكاتب خالد خليفة يمارس تمارين الحياة كل يوم بين موتى، كما يذكر في أحاديثه الخاصة والعامة، كأنه يقول لنا لا موت أبديًا في سورية، الكل يستيقظون منه كأنه مجرد قيلولة صغيرة تحت ظل شجرة مشتعلة، بل كان كما يقول “يتقاسم معهم الموت”، لأن الموت ليس قدرًا وحسب في بلادنا، هو قوت يومي فرضته علينا حرب لعينة، رفض أن يكون وقودها، كما رفض الفرار من أرضها، وها هو يعود بعد كل أسفاره ليلقي بجسده في ترابها المحقون بكل أنواع الأسلحة، من حب الكراهية، إلى سكاكينها المفقودة.
هكذا يذهب خالد إلى الموت المتشبث بالأظافر بقوة تليق بأحلامه الكبيرة، جالسًا على كرسيه محدقًا بأفق الممكن والمستحيل، يجمع بين السوريين، يحررهم من “مديح الكراهية”، ويأخذنا إلى طاولة واحدة يمد جسده بيننا، ويُجلسنا حولها، وهو يراهن بموته على شفاء أجسادنا من “شقوق سكاكين متقيحة لم تندمل بعد” من انقساماتنا، على الرغم من أننا جميعًا ضحايا تنز جراحنا المثقلة بالتصنيفات الدينية والمذهبية والقومية.
ويحرج خالد بجسده المتمدد كل سياسيي العالم، ويلقي بخطبهم عن حرب أهلية في سورية في أقرب درج تنام فيه قراراتهم الأممية، ها هي سورية بشعبها، لا حرب طوائف، ولا مرجعيات قومية، لا معارض ولا مؤيد، لا صفات تفريقية، كلنا مصابون برحيلك المبكر عنا، كلنا يعرف معنى أن “الموت عمل شاق”، وأنك أكثر رهافة من أن تجبرنا على امتهانه معك، واقتسامنا مره منك.
ليست فقط الحواجز المدججة بالسلاح هي من تعيق السوريين كل السوريين عن مرافقة جثمانك، على “درب المقبرة الموحل”، لأن الحواجز التي علينا تجاوزها يا خالد ليست صعبة، بل مستحيلة، هي حدود لا يمكن دخولها من دون موافقات أمنية، وضمانات سلامة، واتفاقات دولية، ووثائق سفر تمنع حامليها من دخول بلادهم، وقرارات تحتاج إلى إجماع أممي يصعب تجاوز حق النقض فيه، ومليارات دولارات تتدفق إلى جيوب النظام السوري للسماح بإعادة إعمار جسر عودة اللاجئين، الذين كنت تنتظرهم مثقلًا بحلم العودة والسلام، وبيقظة قريبة لمن مات على أمل الرجعة.
ها أنت ترحل من دون أن تمدنا بتلك القوة على الصبر على مستحيلات العيش! لماذا تصر على أن تكون أحد الضحايا القادرين على الرحيل؟ سأعترف لك هذه المرة أنني تمنيت لو أنك طاغية لا تموت، ولكنني عدت لأتذكر أنك لا تسفح الدماء كما هم أبطال الجريمة في واقعنا الذي تصوره كما الحقيقة الناطقة، نعم “دماء الضحايا لا تسمح للطاغية أن يموت”، وأنت طاغية حب لا طاغية قتل، تعيش بالحب من أجل موت هادئ، طارئ، مؤقت، موت لا يموت فيه الأحبة، و”أن الأموات ينهضون”، يرقصون، يفرحون، ويضحكون، فمتى تنتهي قيلولتك المفاجئة، وتعود لتنتظر معنا موتنا القادم؟
كما الحب هو القاسم المشترك في أعماله الدرامية التي كتبها، وبقيت مقياسًا معياريًا على مدى عقود لألق كتابة الدراما السورية من “قوس قزح”، إلى “سيرة آل الجلالي”،) و”هدوء نسبي”، و”ظل امرأة”، كذلك كان الموت هو القضية التي يتعاطى معها بكل حبه للحياة وتمسكه بها.
كان خالد خليفة هو روح الكلمة التي يودعها بين دفتي كل رواية من رواياته الستة “حارس الخديعة”، و”دفاتر القرباط”، و”مديح الكراهية”، و”لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، و”لم يصل عليهم أحد”، و”الموت عمل شاق”، يموت مع أبطالها، ويعود إلى الحياة معنا بعد تجربة موت مضنية، وكأنه يقدم لنا موته اللاحق هذا في طبق من الحب، مذاقه مر، ينتزع من عيوننا دمعها، لنستقبل رحيله بهدوء الصابرين على مصابهم، ومصيبتهم.
رحل خالد خليفة ليتركنا نتجرع تجربة الموت الشاق، نقف على أعتاب حدود المكان عاجزين عن تخطيه، نكتب عنه ومنه، يتذكر كل منا أحاديثه المشتركة، مواقفه الجريئة، نتصفح رواياته كأنها المرة الأولى، والعاشرة، الموت، الموت، الموت، حتى صار الموت صديقًا مشتركا يسامرنا في الليل، ويتناول طعامه من أطباقنا، وينهض صارخًا في وجوهنا كلما ضاقت بنا الحياة، أنا الموت الذي يحيا بكم، فمن أي شيء آخر تخشون؟
سامحك الله يا خالد، أيُّ ألمِ تركتنا نتجرعه في حياة لا تختلف عن الموت في غياب الوطن والأهل والأحبة؟
فتى الرواية السورية الجميل
راسم المدهون
منتصف التسعينيات، تعرفت على خالد خليفة الكاتب الشاب في تلك الأيام، وصاحب رواية أولى “حارس الخديعة”. كان لافتًا ومهمًا عندي ما قاله لي الروائي الراحل هاني الراهب الذي عرّفني على خليفة: انتبه لخالد… إنه أمل الرواية السورية القادم بقوة. لاحقًا صرت وخالد خليفة صديقين، وأذكر أن عمق لقاءاتنا وأهمية صداقتنا كانت بعد نشر مقالتي عن روايته الجميلة، والتي أطلقت اسمه بقوة في عالم الرواية، وأعني “دفاتر القرباط”، وهي المقالة التي أشارت للجماليات الفنية والبناء الروائي المتماسك والمشحون بالدراما، والتي لا أزال أعتقد أنها تحتل مكانتها الخاصة بين رواياته جميعًا.
خالد خليفة الصديق والكاتب هو عندي صورة حلب، وهو بمعنى ما ابن العشق الحلبي الفائق للحياة، والذي اعتدنا أن نلمسه في تراث حلب الفني، تمامًا كما عرفناه من عشق أهلها للفنون جميعًا، وبالذات الموسيقى والغناء، ولعل ملامح المدينة التاريخية العريقة قد وجدت طريقها إلى حضور خالد خليفة الشخصي وعشقه العميق للحياة بكل أبعادها، بل حتى في تماهيه مع أصدقائه الكثر، واعتبارهم جزءًا حميمًا من حياته.
في آخر لقاء لي مع خالد، أذكر أننا التقينا فجأة، على ناصية شارع في دمشق، فدعاني لأتناول معه “ساندويشتي” فلافل ساخنة، كنا خلال التهامهما نتحدث عن شيء واحد: كم أننا في تلك اللحظة كنا نتصرف كأننا من “القرباط”، أولئك الذين استدرجتهم مخيلة خالد خليفة إلى صفحات روايته “دفاتر القرباط”.
يغيب، وأغيب، وحين نلتقي بعد ذلك نحس أننا لم نغب، فهو قرأ جيدًا كل ما كتبت، وأنا “التهمت” ما حقق من روايات، وكان ولم يزل لافتًا بعد قراءة كل رواية له أن أقف مع جمالياتها الفنية ومعمارها الروائي الراقي، باعتباره حدثًا “عاديًا”، أي أنه لم يفاجئني أبدًا، وكأنني كنت أمشي خلال ذلك على المقولة الأولى التي كانت مفتتح تعرفي على خالد خليفة، والتي قالها لي الراحل الكبير هاني الراهب: خالد هو أمل الرواية السورية القادم بقوة.
هو، أيضًا، أحد أبرز من كتبوا الرواية، ليس في بلاده سورية وحسب، ولكن أيضًا على المستوى العربي، فذاكرتي تضعه في صورة مستمرة مع كوكبة من الأسماء الروائية العربية البارزة والمرموقة، والتي يقف فيها إلى جانبه من كتاب سورية الروائي الصديق خليل صويلح، أطال الله عمره، وكلاهما من جيل الرواية السورية الجديد الذين يؤكد وجودهم وتألق رواياتهم تجاوز الرواية السورية مكانتها الأولى إلى مقام أعلى وأرفع في الثقافة العربية عمومًا.
لعلّ أهم ما قدمته تجربة خالد خليفة الروائية هو الحفر العميق في “طبقات” المجتمع السوري، وما تحمله من تطورات تاريخية، ومن أحداث ووقائع لا تستقيم قراءتها إلا لكاتب روائي عميق الرؤية وبالغ الصبر يستغرق أعوامًا طويلة لكتابة تلك الحفريات الاجتماعية رواية كما فعل مع روايته “مديح الكراهية”. وأعتقد أنه في تلك الرواية كان الكاتب الذي يتوغل وراء الأحداث والبنى الاجتماعية، ويذهب نحو استنطاق الشخصيات بما هي دلالات كبرى، واضحة ومؤثرة على ظواهر اجتماعية ووجودية. ولم أستغرب أبدًا أن الراحل حين كتب أعمالًا درامية قد نجح أن تكون أعماله منتمية تمامًا، فنيًا وسردًا، إلى ما أسميه عادة “الرواية التلفزيونية”، كما فعل هو بالذات في مسلسله الشهير “سيرة آل الجلالي”، التي برعت في تشريح طبقة التجار وعوالمهم في مدينة حلب، وهي ميزة أعتقد أنه تفرَد بها بين زملائه من كتاب الدراما السوريين، ولفتت الانتباه إلى أعماله، باعتبارها مزجًا للأدب والدراما التلفزيونية على نحو فني جميل. وأهمية هذا يمكن الوقوف عليها من خلال تأمل المكانة الفنية للدراما خلال العقود الأخيرة، وبالذات في مرحلة نهوضها الكبير، وتبوئها مكانة عليا بين الدرامات العربية التي أصبحت حاضرة ومؤثرة في كل البيوت العربية.
الحديث عن الروائي الراحل خالد خليفة لا يستقيم من دون الحديث عن رحلته مع جوائز الرواية، خصوصًا “الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر”، التي بدأت مع الدورة الأولى للجائزة، حيث وصل إلى القائمة القصيرة، وفاز يومها الروائي المصري بهاء طاهر بالجائزة، على أن جائزته الأهم في تقديري كانت في اختيار روايته “مديح الكراهية” ضمن قائمة “أهم 100 رواية في العالم في كل العصور”، وهو اختيار نادر لم يشاركه فيه من الروائيين العرب سوى نجيب محفوظ، وإلياس خوري، وإبراهيم عبد المجيد، وهو اختيار لم يكن ليتحقق إلا بعد ترجمة روايته لعدد كبير من اللغات العالمية، ومنها بالطبع اللغات الأوروبية الأبرز، الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، ووصولها إلى أوسع دائرة من القراء.
خالد خليفة جاء إلى الأدب والكتابة في “زمن الرواية” وما شهدته الساحة الأدبية من منشورات روائية لا تحصى خلال العقود الثلاثة الماضية، لكنه نجح في تحقيق بصمته الكبرى التي لا تنسى على هذا الجنس الأدبي الجميل والصعب، والذي ظل دائمًا صنوًا ملازمًا للتاريخ والسياسة وعلم النفس كما لعلم الاجتماع، بالنظر لما يحمله الفن الروائي من توغل عميق في تلك الأقانيم كلها بحثًا عن وجوده وأدواته، بل وموضوعاته السردية، كما لا يحدث مع أي جنس أدبي آخر، فاختار أن يحقق تميزه، وأن يقدم براعته ورؤاه العميقة.
رحل خالد خليفة عن عالمنا قبل أن تطأ قدماه الستين من عمره، بعد أزمة قلبية مفاجئة، وقد رحل في ذروة عطائه وتألقه الفني هو المسكون بالأدب والكتابة، وبالرغبة في التعبير عن الحياة بكل أشكالها وتفاصيلها، لأنه خلال حياته الواقعية والروائية، على السواء، ظل ابن الحياة والناطق باسمها.
تصادم المُفجع مع المُؤثِّر
أنور محمد
في روايات خالد خليفة تقبض على حسٍّ نقدي في غاية التهكُّم من الوقائع الاجتماعية والسياسية التي مرَّت على سورية من نهايات القرن التاسع عشر إلى الآن، فنمسك بروح مثقَّف وطني تذهب شخصيات رواياته إلى مصائر مفجعة، وهو الروائي السوري الذي خلَّص الرواية من الثرثرة، ومن الإفراط في الخيال، فيتصادم كما في “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” المُفجع مع المُؤثِّر.
في روايته “مديح الكراهية”، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى في عام 2008، سنجد أنه كتبها بحذرٍ شديد، حيث نَقَدَ وانتَقَدَ كلًا من المشتغلين في السياسة؛ الدولة التي تدير شؤون رعيتها، والمشتغلين بالدين ـ المعارضة الإخوانية التي لجأت إلى السيف الدموي، فجاء ردُّ الدولة بالسيف. هو في هذه الرواية كبالع السكين على الحدين، أو كمن يمشي في حقل ألغام وعليه أن يعبر إلى الجهة الأخرى. فكلا المتحاربين لا يسمحان بأن يتجرأ (روائي)، أو مثقف، عليهما، وبقلم النقد لا بسيفه، سيما وأنّ الرواية ترصد نشاط الإخوان في الجامعة، من توزيع بطلتها منشورات سرية بين رفيقاتها، إلى نقل معلومات سرية تُسهِّل عمليات الاغتيال، حتى تُعتقل وتدخل السجن، وهي التي تدرَّجت في الكراهية، شربتها وشرَّبتها، بل وأوجدت مبرراتٍ لها قبل أن تكتشف في النهاية زيف هذه المبررات وهشاشتها، فتقول لنفسها: “أحتاج إلى الكراهية كي أصل إلى الحب“. خليفة كتب “مديح الكراهية” بشجاعة عقلية، كان يدافع فيها عن الناس وحقوقهم المدنية في الحياة، من دون أن يمسَّ جوهر الدين وجوهر السياسة، إلاَّ بما يكشف وينتقد تأويلات الطرفين في تبرير سفك الدماء، وبما يغني ذاتية السوريين كونهم ضحايا الاقتتال.
روايته “مديح الكراهية” كانت بمثابة ضربة مُعلِّم. وقد تمَّ منع تداولها في سورية، لأن خالد لم يكن حياديًا، بل كان ضدَّ سياسة القمع وترهيب الناس، ما يعني أنَّه في هذه الرواية، وإن جاءت بعدها رواية “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، ورواية “لم يصلِّ عليهم أحد”، أخذ موقفًا جريئًا من الصراعات الدائرة، فالحرية ليست للذي يسيطر ويهيمن. وهو، أيضًا، كشف المستور، فجعلنا نرى السوريين وهم يُكرِّهون بعضهم بالوطن بدلًا من أن يحبُّوه حين تمَّ تقسيمهم إلى مذاهب وطوائف وعشائر وإثنيات، ليسهل اصطيادهم كما يسهل رميهم ببعضهم ـ وقد حذَّر من ذلك؛ فيغلب تقديس المذهب على تقديس سورية، وإن كنَّا ضد فكرة التقديس. وهو بهذه يعطي للرواية السورية مصداقيتها، فلا تتجسَّس على حياة البشر، بل تصير صوتهم. نقرأ، هنا، رواية من العيار المأساوي (الصوفي ـ العرفاني) الثقيل، من دون استعمال سيف الأيديولوجيا/ العقائد واستهلاكها في بناء الرواية. لقد كان خالد خليفة في هذه الرواية دقيقًا وخشنًا في قول رأيه كمثقف نهضوي، فلا يمارس السياسة في الرواية بعقلية البدوي، وإنْ مارسها، فهو يحفر في ما وراء السياسة؛ في الثقافة التي تنفذ إلى الواقع الراهن، محاولًا التأثير فيه من خلال شخصيات الرواية.
الروائي والسيناريست والشاعر خالد خليفة لم يستنسخ شخصياته في روايته “مديح الكراهية”؛ بل كانت بنت اللحظة التاريخية، وكان مندمجًا معها مثلما اندمجنا معها في كُرْهِ الذي يفرِّق ويوغر الصدور بين أبناء الوطن الواحد، وكأنَّه في هذه الرواية يؤسِّس لما يمكن اعتباره تاريخية الخطاب الروائي السوري والعربي.
نشرت على ضفة ثالثة هنا







